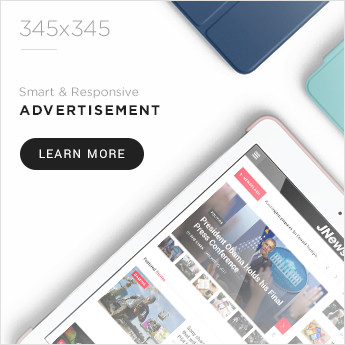سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجالات العلم والمعرفة ، لإبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ، والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق معرفتهم ، وموسوعية علمهم ، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسور التلاقح بين المفكرين وبني عصرهم ، وبين المفكرين وطبقة قرائهم ، وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.
في هذه الحلقة ننهي حوارنا مع المحامي والروائي الأستاذ بهاء الدين الطود في جزئه الثالث والأخير.
الأستاذ الطود ، هل سبق لك أن درست الأدب من قبل ؟
جوابا على سؤالكم ، أخبركم أن نقادا كثيرون أكدوا أن كتابتي للرواية جاءت في وقت متأخر من عمري ، بذلك فلستم المحاور الأول من أثار هذا التساؤل .
إذن فعلا ، فقد كتبت روايتي الأولى البعيدون وأنا في سن الأربعين ، وقد لا يختلف معي أي مهتم بهذا الموضوع ، بأن الرواية هي أكثر الأجناس الأدبية استنادا على ثقافة عامة متنوعة كإلمامه بعلم النفس والاجتماع والتاريخ والشعر وغيره .
هذه العلوم للإحاطة بها لا تكتسب في وقت قصير، ودليلي على ما أقول ، أن شيخ الرواية العربية الحاصل على جائزة نوبل في الأدب ، نجيب محفوظ ، قد بدأ كتابة الرواية في سن الأربعين ، أي بعد أن كتب مقالات فكرية وأدبية وسيناريوهات سينمائية متنوعة .
كما أن الروائي المغربي المفكر عبد الله العروي ، حين كتب أولى روايته ” الغربة ” عام 1971 ، كان قد اشتهر بكتابة التاريخ المغربي والفكر العربي والغربي ، ولم يأت لكتابة الرواية إلا حين اقترب عمره من الأربعين .
بذلك فإني أيضا قبل أن أكتب الرواية ، قدر لي أن أمارس الكتابة في مواضيع متنوعة .
بقدر ما أسعدني هذا الاهتمام الكبير بروايتي الأولى ، سواء في البلاد العربية ، أو في إسبانيا ، وأمريكا اللاتينية بعد ترجمتها إلى الإسبانية ، ففي الوقت ذاته أصابني الارتباك ، إذ صرت أهاب الكتابة في مستوى أقل إبداعا من روايتي الأولى ، فانشغلت بقراءة الأعمال الإبداعية وغيرها لمدة تقرب من عشر سنين ، قبل أن أكتب روايتي الثانية ” أبو حيان في طنجة ” ، لأجعلها إن صح تعبيري إبحارا في الثقافة العربية ، بعد أن كانت رواية ” البعيدون ” إبحارا في فضاء الثقافة الغربية ، وشخصيا أراهن على الكيف أكثر من مراهنتي على الكم ، عملا بالمقولة العربية ، شاعر بقصيدة .
بعد ذلك أنجزت عملين سرديين ، الأول يحمل عنوان ” رسائل بيلار ” وهو قيد الطبع ، والثاني بعنوان ” سارق الآسفار ” يقترب من مذكرات تمزج بين سيرة ذاتية ، وسرد فكري يتماهى مع اليوميات .
كما أن الروائي المغربي المفكر عبد الله العروي ، حين كتب أولى روايته ” الغربة ” عام 1971 ، كان قد اشتهر بكتابة التاريخ المغربي والفكر العربي والغربي ، ولم يأت لكتابة الرواية إلا حين اقترب عمره من ألربعين .
بذلك فإني أيضا قبل أن أكتب الرواية ، قدر لي أن أمارس الكتابة في مواضيع متنوعة .
ـ الأستاذ الفاضل ، كيف انتقلت من مهنة المحاماة إلى الكتابة الروائية ؟
عن سؤالكم كيف انتقلت من المحاماة إلى الرواية ، فإني أرى أنه ليس حتما أن يكون التطور أفقيا ، بل قد يكون عموديا ، أي أن ينبع من مكونات متعددة ومتنوعة نفسية واجتماعية وثقافية . فالذين أتوا إلى الرواية من خارجها ، لم يأتو من انشغالات مغايرة على مستوى جوهر الإبداع وعمقه ، وهو ما يفسر أن كبار الروائيين ، عربا وأجانب ، جاؤوا إلى هذا الفن من خارجه ، فيوسف ادريس جاء من مهنة الطب ، وعبد الرحمان منيف من علم الهندسة ، والروائية المغربية فتيحة مرشد ، جاءت من مهنة طب الأطفال ، والروائي الإيطالي أمبيرطو إيكو ، جاء من السيميائيات ، وعبد ربه من القانون .
بذلك فإن القدوم إلى الرواية من خارج الرواية ، لا يجب أن يدعو إلى أي تساؤل أو استغراب ، فالإنسان لا يأتي إلى الشيء إلا من خارجه .
أستطيع أن أختصر كل هذا ، بأن الروائي يصنع حقا بالثقافة بمعناها الواسع ، لكن يجب أن يكون مفطورا على الحكي والسرد ، ومنتبها إلى الكيف قبل الكم ، فهناك من كتب عشرات الروايات دون أن ينجذب قارئه إلى واحدة منها .
إن جدلية الاستعداد الفطري مع الاكتساب الثقافي ، هي ثنائية تصنع كاتب الرواية ، سواء جاء من الطب أو القانون أم الإعلام ، فلا بد للقادم أن يأتي من جهة ما .
ـ الأستاذ الطود ، هل تعني بما قلته ، أن ثقافتك العامة هي من رفعك إلى كتابة الرواية ؟
ليست الثقافة وحدها من يصنع الروائي ، بل هي شرط أساسي يضاف إلى الموهبة والرغبة ، والترحيب بما هو جميل في الطبيعة والبشر ، ففي الليل تفتح العين لتأمل السماء ونجوم مصابحها ، وتغمضها عن تأمل الظلام ، وفي بني البشر، إبداء الإعجاب بالسلوك الجميل الصادق ، والمواقف الإنسانية ، مع الإحجام حتى عن الإنصات للشر، فالكتابة الجميلة تستند على الإحساس بالجمال وتذوقه .
إن الروائي صاحب الذوق الجميل ، يبدع ما يزخر بالمتعة والجمال ، وذا الذوق السيء لا يبدع أبدا .
أما تجربتي الروائية في تقديري ، فهي تنهل من مكونات متشاكسة ، ففي طفولتي كنت مهوسا بالسرد ، أحول كل ما أقوله إلى بنيات سردية دون أن أعرف السبب ، وكنت أكثر أشقائي ممن يكبرني ويصغرني ، إلتصاقا بوالدي في أسفاره ، وعند زيارة أصدقائه في أفراحهم وأقراحهم ، دون أن أعرف السبب أيضا ، ولربما كان سبب ذلك جرأتي وعدم انطوائي .
ولكوني أقدمت على دراسة الصحافة قبل القانون ، فقد صار اهتمامي وما يزال بالإعلام والفنون أكثر قليلا من القانون ، خاصة بالفن التشكيلي والمسرح والسينما والشعر وغيره ، لأكتشف بعد ذلك أن التعبير السردي الروائي ، أقرب إلى نفسي من أي شكل تعبيري آخر ، وأن الرواية هي الأقدر كشفا عما يجيش به صدري من قلق ومشاعر وأحلام .
كما أن قسماتي النفسية في أساسها ، تتمثل في الرؤية الكلية للأشياء ، والنفاذ إلى الأشياء الصغيرة والتفاصيل الدقيقة التي هي جوهر الرواية ومادتها التصاقا بها .
ـ سؤال : روايتك الأولى ” البعيدون ” حظيت باهتمام وترحيب في الصحافة العربية ، ومما قرأته أنها أكثر الروايات المغربية مبيعا ، وأن كل طبعة شملت ثلاثة ألف نسخة ، وعدد الطبعات إلى اليوم وصل إلى أربع طبعات ، فيكون مجموع ما طبع قد وصل إلى اثنا عشرة ألف نسخة .
يضاف إليها الطبعات المصرية التي تزداد بالآلاف ، بسبب توزيعها على جميع ثانويات جمهورية مصر العربية .
فهل الروائي المغربي يتاح له العيش من مداخيل أعماله ؟
من جهة أخرى ، هل السبب في نجاح رواية البعيدون ، هو الموضوع الذي تطرقت إليه ، بتيمة إشكالية الأنا والآخر ، وقربه من سيرة ذاتية في مدريد وباريس ولندن والقصر الكبير ، وقد سبقك قديما للتطرق إليه الروائي توفيق الحكيم في روايته ” عصفور من الشرق ” والروائي سهيل ادريس في روايته ” الحي اللا تيني ” ، وكذا الروائي الطيب صالح في روايته ” موسم الهجرة ” . أم ترى أن نجاحها يعود إلى اللغة الشاعرية التي تجذب القارئ إليها ؟
أشكرك على تثمينك الإيجابي لروايتي ، وأنقل لك إعجابي باطلاعك على روايات عربية جيدة .
لكني أجيبك بأني لا أرى أن هناك مواضيع قديمة وأخرى حديثة ، فكل المواضيع والتيمات قابلة للرؤية من زواية أو زوايا مختلفة ، وفي أزمنة مختلفة ، فقضايا الحب مثلا ، أو الوطن ، أو علاقة الرجل بالمرأة ، ما زالت إشكالات وتيمات مطروقة من عهد ” حمورابي ” أو امرئ القيس إلى عصر ” نجيب محفوظ ” وعبد الله العروي وفاتحة مرشيد وغيرهم . إن جميع الثنائيات الضدية ، من خير وشر ، ومحبة وكراهية ، كلها كانت وستظل مواضيع مطروقة إلى ما شاء الله .
أما استفادتي المادية من مبيعات الطبعات المغربية التي تصل إلى اثنا عشرة الف نسخة ، فجلها ما يزال الأسواق بأمل أن تتولى تغطية مصاريفي عنها .
أما بشأن الطبعات المصرية ل ” البعيدون ” ، فقد تنازلت عن أي تعويض مادي عنها .
وحين توصلت بكتاب من مؤسسة دار الهلال لأوقع معها عقدا .
سافرت فعلا إلى القاهرة وكان أحدهم قد أوصاني أن أطالب المؤسسة بتعويض مادي مهم ، لكون روايتي ستوزع على جميع ثانويات الجمهورية المصرية ، كما نصحني أقارب لي أن أتنازل عن أي تعويض مادي للمؤسسة مقابل دعمها لأول رواية لي ، أوصلتني إلى مصاف كبار الروائيين العرب .
في القاهرة ، قابلت الأستاذ أكرم محمد أحمد ، رئيس مجلس إدارة دار الهلال ، فكاد لا يصدق نية تنازلي عن أي تعويض مادي.
واشتعلت بيننا صداقة جميلة في القاهرة ، وفي المغرب بعد أن زار أصيلة بدعوة من مهرجانها الثقافي السنوي .
إن نيتي الحقيقية بتنازلي عن التعويضات ، تؤكد تقديري للإبداع وعشقي واستمتاعي بما أكتب .
أما عن استفادة المبدع ماديا من مداخيل أعماله ، فعلي توضيح هذا بإيجاز، أن جميع المبدعين العرب في أجناس إبداع الرواية أو الشعر أو الفكر عموما ، لا أحد منهم يقوى على العيش من مدخرات مبيعات أعماله ، إذ لابد من مصادر أخرى لعيشه ، وأسوق لك أمثلة عن هذا .
فالروائي المرحوم محمد شكري من طنجة ، عانى فقرا من مبيعات أعماله ، لكن بعد أن ترجمت هذه الأعمال إلى اللغات الأجنبية ، انتعشت ظروفه المادية وأصبح ميسور الحال ، فمن عادات الأجنبي اطلاعه المستمر على ما ينشر ، حتى لو كان ذلك بثمن مرتفع ، فهو يخصص قسطا من ماليته للقراءة . إن ما ينشر في مدينة مدريد وحدها يفوق ما ينشر في جميع أقطار البلاد العربية .
كما أن الروائي اللبناني ، سهيل ادريس ، لا يقيت نفسه مما يبدعه ، بل مما تديره عليه دار نشره بمداخلها المعروفة بدار الأدب للنشر في بيروت ، وقد حدثني عن هذا شخصيا ، وأتذكر أول لقاء لي به ، كان يوم احتلال العراق لدولة الكويت عام 1990 ، ليتجدد اللقاء في القاهرة والاسكندرية .
عودتي إلى استفادة المبدع ماديا من أعماله ، فمن وجهة نظري أقول : بأن دور النشر في الأقطار العربية ، هي المستفيد الأكبر من عرق جبين المبدع ، إذ يجني نصف أرباحه ، وتجني دور التوزيع ربعا من أرباحه عن وساطتها في البيع ، ولا يتبق للمبدع سوى ربع الإنتاج ، الذي يتبخر في الهدايا ، إذ كل صديق أو قريب أو زميل ، يطلب منك إهداء نسخة له موقعة من طرفك .
بذلك يصعب على المبدع أن يقتات من مداخيل أعماله .
لأكون واضحا أقول لك ، إن عملي الأول ” البعيدون ” ، المترجم إلى الإسبانية ، فاقت مبيعاته جميع ما بيع من الطبعات المغربية باللغة العربية ، وذلك في كل من إسبانيا وأقطار دول أميركا الجنوبية ، مع أن سعر النسخة المترجمة ، يفوق ثمنها سعر أضعاف العربية .
وهذا ليس معناه أن كل عمل مترجم سيلقى نجاحا ودعما ، فالأجنبي في الغالب يختار ما سيقرأ .
مما يدعوني لأقدم لك تجربتي في هذا الموضوع .
بعد أن تولى ترجمة روايتي ” البعيدون ” إلى الإسبانية صديق إسباني من أصل مصري ، يعمل أستاذا للنقد بإحدى جامعات مدريد ، برفقة صديق له شاعر إسباني ، توقف حمار الشيخ في العقبة ، بحثا عن دار نشر تقبل نشرها ، إذ كان اقتراحي اختيار دار متميزة ثقافيا .
في الأخير اهتدينا إلى دار نشر تسمى ” المرآب ” ، قيل عنها أنها في مستوى دار الهلال المصرية أو كاليمار في باريس .
لأكتشف عن طريق الصدفة أن صاحبها ” مانويل بلانكو تشيفطي ” ، وقد درسنا معا بمعهد الصحافة وسكنا سويا مدة عام كامل في شقة بمدريد مع رفيقين آخرين من المعهد ذاته .
عند لقائنا ـ مانويل وأنا ـ اقترب سلوكنا من فرح الأطفال تعبيرا عن اشتياق كل منا للآخر .
انتقى مانويل طبعة جيدة للرواية ، زينها بغلاف به صورة لفتيان في عامهم الدراسي الأول من معهد الصحافة بمدريد لعام 1966 ونحن من بينهم في عمرينا التاسع عشر، وجل أصحاب الصورة يعمل اليوم في الصحافة بأنواعها المختلفة .
وستعمل دار النشر ” المرآب ” على تقريب الرواية من القراء ، سواء في إسبانيا أو أمريكا الجنوبية .
في الأخير، لا أعرف من لعب دوره في هذه التفاصيل التي أذكرها ، هل الصدفة أم الحظ ، ويحضر بيت من قصيدة الأطلال للشاعر إبراهيم ناجي ، التي يقول في آخرها :
لا تقل شئنا فإن الحظ شاء .
وهذا تساؤل مني ، إن كان للصدف دورا في مسارنا ؟
انتهى .
إعداد : عمر محمد قرباش