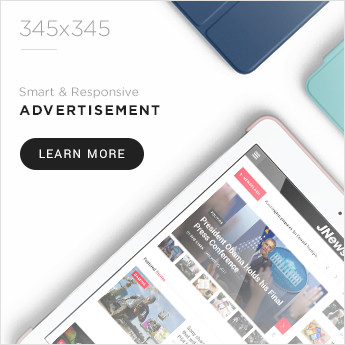لم يبق في مخيلتي، من ذكريات الطفولة عن الحمامات الشعبية، سوى مشاهد حركية هزلية لذوات هزيلة تبدو كأشباح مقوسة تحمل دلاءا، وأخرى بدينة منبطحة مثل تتفصد عرقا، وسط فضاء بخاري عابق بروائح خشب التدفئة والصابون، وجلبة أصوات كأنها صادرة من بطن بئر عميق.
لقد جرت العادة، في زمن الجمر و الخشب، أن أرافق والدتي -مرة في الأسبوع- إلى حمام “السعادة” بعين السبعى، وسني آنذاك لايتجاوز الخمس سنوات.وكلما ولجت ذاك الفضاء الساخن، إلا وأحسست بفرحة عارمة تنسيني في صخب الحمام وفرط حرارته…
والذي كان يشد فضولي الطفولي إلى حمام النساء ، هي تلك الأجساد العارية المنبطحة على الأرضية الحامية كحروف أبجدية في أوضاع غير عادية، وكذا حركية المستحمات وهن يسلخن أجسادهن الناعمة بمحكات حجرية خادشة وأكياس قماش خشنة..فتراهن بين مثنى وفرادى يحككن جلودهن بتفان وعناد..وجرت العادة على أن تستعين الجارة بجارتها أو بإحدى صويحباتها أو المقربات إليها من أجل مد يد المساعدة في الحك والدلك، أما اللواتي يرفضن الاندماج مع باقي المستحمات اتقاء لشرهن فإنهن يجدن بغيتهن عند الكسالة/الطباخة الماهرة في تدليك الجسد وإزالة الأوساخ العالقة به، وللكسالة أسلوب خاص في مجاملة المستحمات المثقلات بالأساور والسلاسل الذهبية، ولاتتوانى في تسليط سلاطة لسانها على المتسلطات عليهن المتجاوزات لحدوده.
وقد ينشب صراع بين بعض المستحمات فتتحول أرضية الحمام إلى بركة دماء ،وأستحضرفي هذا السياق مشاجرة بين مستحمتين كانت عاقبتها رشقب إحداهن رأس الأخرى بمحكة حجرية ففارت الدماء ثم أغمي عليها ولم تستفق من غيبوبتها إلا بعد تلقيها إسعافات أولية بردهة خلع الملابس، ويعود سبب إلى كون المعتدى عليها استحوذت على مجلس رحب واحتكرت عددا وفيرا من الدلاء “القباب” وضعتها مرصوصة كشارة حدود فاصلة بينها وبين باقي المستحمات، فلما طلبت منها صاحبة دعوتها أن تفسح لها مكانا للجلوس طارت في وجهها كالقطة المسعورة فتناتفتا وتهارشتا فوقعت الواقعة. كنت ساعتها في الغرفة المجاورة أتزحلق بعدما دهنت بدني خلسة بالصابون البلدي، ذاك الصابون الأسود اللزج الفعال الضروري لترطيب الجلد قصد التمكن من تنظيفه مما علق به من أوساخ.
ولما بلغت سن التمييزحرم علي حمام “نون النسوة” وفتح في وجهي حمام “واو الجماعة”، هكذا وفي سن مبكرة التحقت بمصاف الكبار بعدما ولجت عالم الرجال من باب الحمام. ومادام الحمام بيت طهارة فإن أبوابه تظل مفتوحة إلى مابعد آذان الفجر، وأحيانا إلى أن تطلع الشمس وتستقر في كبد السماء.
وإذا كان الحمام بالنسبة للنساء المكان المفضل لإفراغ المكبوتات واستعراض المفاتن ، فإنه بالنسبة لأشباه الرجال هو المكان”الفنطازي” لاستعراض العضلات واجترارحكايات البطولة والمغامرة والغراميات ـ
وفي زمن الغفلة كان بعض القواد والشيوخ وكبار ملاك الأراضي وأصحاب النفوذ و”الشكارة” يكترون الحمامات الشعبية لإشباع نزواتهم الطائشة في الخفاء بعيدا عن عيون الرقباء.
واستعدادا لليلة “الدخلة” يستفرد “سيد السلطان” وحاشيته بالحمام، كما تستفرد به، ولنفس الغاية “للا السلطانة” ووصيفاتها حاملات الشموع وطبق زينة يشمل الورود المجففة والحناء والغاسول المسقي بماء الزهروالعكر الفاسي والسواك والمكحلة ذات المرودة وقنينات عطور.
وأحيانا يتحول الحمام إلى استوديو غناء، حيث يستمتع البعض بأداء مواويل ومقطوعات غنائية يرردها الصدى.
وتنسج عن الحمام أساطير وحكايات حول الجن الذي يختطف الحسناوات أو يلحق عاهات مستدمية بالمستحمين والمستحمات.
تدخل الحمام فتستقبلك قاعة الجلوس بهياكلها الخشبية المتراصة، حيث يتم التجرد من الملابس والتخلص من الأحذية، وحين تنسلخ من ثيابك ونعالك تحمل دلويك وتلج إلى الغرفة الصفر – عادة ماتكون خالية من المستحمين – وهي دافئة نسبيا، ثم تنزل إلى الغرفة الموالية وهي أكثر إعتدالا، فالثالثة وهي الأشد حرارة وبها حوض الماء الساخن “البرمة” وهذه الغرفة هي محراب الطهارة البدنية ،ودون ولوجها والاسترخاء في رحابها لايستقيم استحمام ولاحصلت راحة عظام، إنها قبلة المستحمين ومنها يستمدون طهارة أبدانهم.
“الدخول إلى الحمام ليس كالخروج منه” تلك بلاغة شعبية مفادها أن المرء يدخل الحمام وسخا قلقا وبعد الاستحمام يخرج منه نظيفا مرحا ؛وفي الحمام مزايا مثلما ذكر الفضل الرقاشي حين قال:
“ونعم البيت الحمام، يذهب القشافة، ويعقب النظافة، ويهضم الطعام، ويجلب المنام، وينفي الغضب، ويقضي الأرب”.
ولايجوز، في هذا المقام، تجاوز ذكر السرقات التي تستهدف ملابس وأحذية المستحمين، ولاأنكر أنني كنت ممن دخل الحمام منتعلا وخرج منه حافيا، شأني شأن أبي سكرة الذي وصف ماوقع له بإحدى حمامات بغداد حين أنشد هاجيا:
إليك أذم حمام ابن موسى
وإن فاق المنى طيبا وحرا
تكاثرت اللصوص عليه حتى
ليحفى به المرء ويعرى
لم أفقد به ثوبا، ولكن
دخلت محمدا وخرجت بشر.
محمد وطاش