يعد الزواج من القضايا التي اعتنت بها الشرائع السماوية، إذ هو من سنن الأنبياء والمرسلين، وقد أجمعت الكتب السماوية على قدسيته، ومشروعيّته وأهميته في حياة الإنسان، لما فيه من تحقيق المصالح ودرء المفاسد وعمارة الكون، ودوره الكبير في بناء الأسرة وإنشاء مجتمع متماسك ومترابط.
ومن مظاهر اهتمام الشرائع السماوية بالزواج أنها حثّت عليه ورغّبت فيه، ووضعت له أحكامًا وطقوسًا معينة، تظهر مدى تقديسها هذا الرباط المقدس، وتقديرها هذه الشراكة الروحية، إذ جاءت بكثير من التشريعات والأحكام التي تنظّم الحياة الزوجية في كل مراحلها، واتفقت على حرمة ما يفسد نظام الزوجية، وأيضا ما يهدد كيان الأسرة ويقوّض أركانها، كالزنا وغيره.
وبناء على مبدأ المساواة؛ لم يعد يُنظر إلى المرأة تلك النظرة التقليدية التي جعلت منها مربية أطفال أو أمًا عطوفًا أو زوجة تنهض بأعباء زوجها، بل صارت ذلك الكائن الاجتماعي الذي تتحقّق هويته فقط عند إسهامه في الإنتاج والنماء الاقتصادي، وذلك عبر الإغواء والدعابة، والجذب الجنسي، ثم تطور تحديث المرأة إلى درجة الاستغناء عن الكيان الأسري والإنجاب.
بيدَ أن الفكر الغربي الحداثي جاء بقيم تعارض كل ما دعت إليه الرسالات الثلاث؛ ولم يعد الزواج ذلك الرباط المقدس والعلاقة الشرعية التي تبنى على أحكام وقواعد دينية، إذ فقد قدسيته وأهميته في كثير من المجتمعات الإنسانية، وظهرت على إثر هذا الفكر تيارات متطرفة ثارت على الأديان والفطرة، وحاربت الزواج الشرعي، والأسرة، والإنجاب.
لقد كان من آثار هذه الحداثة أن ظهرت خلال القرن التاسع عشر دعوات تحرير المرأة؛ التي كانت غايتها إنصاف المرأة ورفع الظلم عنها، وتمتيعها ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دون إعلان الحرب على الأديان والفطرة والأعراف.
غير أن الأمر أخذ يتطور حتى بدأت تتعالى الأصوات المنادية بحرية المرأة، والداعية إلى المساواة بينها وبين الرجل في مجالات الحياة المختلفة؛ في العمل والأجور والميراث، وحتى في تسلم المناصب العليا في المجتمعات.. ولأجل ذلك خرجت المرأة إلى ميادين العمل والمصانع، حتى من غير الحاجة إلى ذلك، وأصبحت تزاحم الرجل لتمارس حريتها الفردية، فنالت كثيرًا من “الحقوق”، التي لم تكن تحظى بها من قبل.
وقد نتج عن هذا التحرر الكبير للمرأة ظهور الحركات النسوية المتطرفة؛ التي تبلورت في الغرب في ستينيات القرن العشرين؛ وجاءت فلسفتها تحمل عدة أفكار هدّامة تجاه نظام الزوجية؛ حيث اعتبرت الزواج مؤسسة وُجدت لمنفعة الرجل، ووسيلة مشروعة للسيطرة على النساء، وأن على النساء العمل على تدميره؛ لأن إنهاء مؤسسة الزواج هو شرط أساسي لتحرير المرأة. بالإضافة إلى أنها شجعت النساء على ترك أزواجهنّ وعدم العيش معهم على انفراد.
اليوم يحاول هذا الفكر الأنثوي بكل السبل تأنيث المجتمعات في العالم، من خلال الدفع بالنساء لغزو كل الميادين الاقتصادية والإعلامية والسياسية، ومحاولة تهميش دور الرجل، والحطّ من قيم الرجولة، والرفع من قيم الأنوثة
وقد عدت رائدات هذا الاتجاه المتطرف، الزواجَ نظامًا قانونيًا يسوغ حبس المرأة فيما يسمى بالأسرة؛ فالزواج والأسرة في نظرهنّ هما التجسيد العملي لتصورات الرجل، والميدان الذي يمارس فيه نزعته الاستعبادية المشروعة دينًا وعرفًا، وأن الخلاص (من هذا الاستعباد) يتطلب بذل كل ما في وسعهنّ لتحطيم طبقة النساء، التي يستخدمها الرجال لتشكيل النساء وفق رغبتهم. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بتحطيم نظام الزوجية (ذكر/أنثى) بوصفه نظامًا اجتماعيًا قائمًا على اضطهاد الرجال للنساء.
كما أدت هذه الحركة الشاذة، المحاربة للزواج الشرعي؛ إلى رفض فكرة “ممارسة الجنس” ضمن إطاره الفطري الذي شرعته الأديان، وألغت مفهوم الأسرة القائم على نظام الزوجية (الذكر والأنثى)، وناضلت من أجل إباحة ممارسة الشذوذ والزواج المثلي (أي زواج رجل برجل، وامرأة بامرأة)، وقللت من شأن الأمومة، وحاربت الإنجاب، وطالبت بالاعتراف بحرية المرأة الجنسية والتناسلية بعيدًا عن مؤسسة الزواج.
وإلى جانب هذه الآفات المهلكة، التي قوضت أركان مؤسسة الزواج؛ فقد أدى توفير موانع الحمل في المجتمعات الغربية، وجعلها في متناول الجميع حتى الشباب، وإباحة الإجهاض، إلى تشجيع الناس على ممارسة الرذيلة، دون أن يكون هناك أي تخوف من حصول الحمل، خاصة مع وجود مؤسسات الرعاية والتربية للأطفال غير الشرعيين.
وبذلك أصبح الجنس مرجعيّة في ذاته، وأصبحت اللذة إحدى الآليات التي يستخدمها المجتمع الحداثي في استيعاب الجماهير في عملية الضبط الاجتماعي، وتتم هذه العمليات بالإغواء، وترسيخ الإحساس بأن حق الإنسان الأساسي والوحيد هو الاستهلاك، وبأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير ممكن عن الحرية الفردية.
وفي خضم هذا الانحطاط والتسيّب الأخلاقي الذي جاء نتيجة للترسبات المنبعثة من قيم الحداثة، والذي أدّى إلى تحطم رابطة الزوجية، وانهيار كيان الأسرة؛ شاع الطلاق بصورة مهولة؛ فبعدما كان الزواج الكنسي أبديًا والطلاق محظورًا إلا في حال ثبوت زنا أحد الزوجين – كما جاءت بذلك نصوص الكتاب المقدس -، اتجهت الدول الغربية في ظل الأنظمة القانونية الحديثة إلى منح الزوجين الحق المتساوي في الطلاق.
بذلك أصبحت – في مقابل هذه القوانين الحداثية – تسجل نسب عالية في حالات الطلاق، إذ أثبتت دراسات غربية أن تجاوز خصوصية نظام الأسرة بإضعاف التقاليد المنظمة لشؤونه أدى إلى ارتفاع حالات الطلاق، وحصل ذلك في عدة دول بعد تعزيز “حرية المرأة” على حساب الأسرة، واستقرارها الذاتي بمنحها المبادرة إلى الطلاق مثل الرجل.
لقد تسربت هذه المفاهيم الحداثية الشاذة إلى عالمنا الإسلامي، عبر الغزو الثقافي، وباتت تشكل خطرًا على نظام الزوجية، والأسرة والمجتمع، بل حتى على الهوية العربية والإسلامية، خصوصًا في ظل ضعف التحصينات الداخلية، والانفتاح بلا وعي على العالم الغربي، فأصبحت هذه المفاهيم تستهدف القضاء النهائي على التراث الثقافي، والمكون الحضاري للأمة العربية الإسلامية، وتسعى لتطبيع الأفراد مع مختلف مظاهر الانحلال والانحطاط الأخلاقي، إذ لم يبقَ في مواجهة الطغيان الغربي المادي سوى الإسلام، وما يحمله من الضوابط والقواعد الأخلاقية.
وتتجلى مظاهر تأثير هذه القيم الحداثية على مجتمعاتنا في ارتفاع أعداد النساء المتأثرات بالفكر النسوي المتطرف بشكل مطرد؛ إذ أصبحت الفتاة ترى الزواج إهدارًا لكرامة المرأة العصرية، وعقبة أمام تحقيق طموحاتها وأهدافها، وباتت العوائل في بلداننا تشجع بناتها على الدراسة والعمل، وتمنحهما الأولوية على الزواج، حتى تشبعت بهذه الأفكار معظم الفتيات في المجتمع الإسلامي، وأصبح الزواج آخر همهن.
كما صارت غاية كثيرات من الزواج – بعد أن تحقق جميع أحلامها – هي الأمومة، ثم بعدها يصبح وجود الرجل في حياتها كعدمه. كل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسبة العنوسة حتى معدلات لم نشهدها من قبل، إذ قاربت في مجملها نسبة الـ 50%، في كل البلدان العربية عام 2023.
كما ارتفعت نسب الطلاق إلى أعلى مستوياتها بعد إقبال المرأة على التعليم والعمل خارج البيت، وسعيها للاستقلال بشكل كلي عن الرجل، بالإضافة إلى الصلاحيات التي باتت تمنحها قوانين الدول للمرأة، وكذلك القيم الغربية الحداثية التي اخترقت مجتمعاتنا، وأدت إلى طغيان النزعة الفردية التي تدعو إليها الحداثة على حساب الأسرة.
لمياء السلاوي





















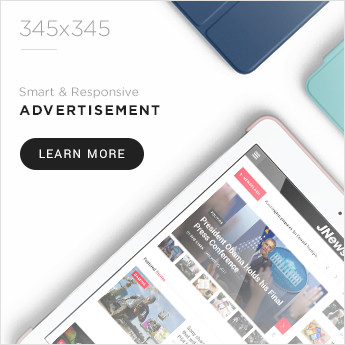



https://shorturl.fm/a5Iqv
https://shorturl.fm/8oaeN
https://shorturl.fm/UgoWL
https://shorturl.fm/TTJ7a
https://shorturl.fm/VRYon
https://shorturl.fm/r769Z
https://shorturl.fm/0NsCp
https://shorturl.fm/7aC9E
https://shorturl.fm/MYOJp
https://shorturl.fm/sL5cy
https://shorturl.fm/SoXIf
https://shorturl.fm/6p8I4
Hi there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.
I simply could not go away your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual info a person provide to your guests? Is gonna be again ceaselessly in order to check up on new posts.