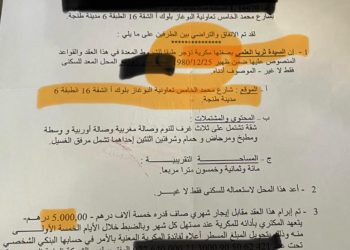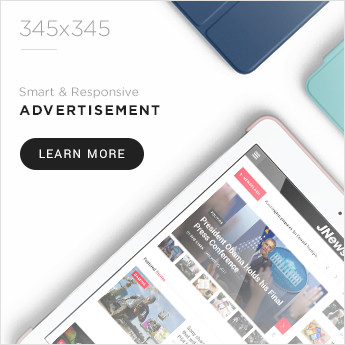إنعدام تمويل البحث العلمي، والاستقلال الأكاديمي والمعرفي، والنزاهة الفكرية وحكامة التسيير والتدبير المالي للمؤسسات التعليمية كلها عوامل تجعل بلدنا في أسفل الترتيبات
قبل بضعة أيام أعلنت جامعة شنغهاي عن تقريرها السنوي، الخاص بالتصنيف العالمي لأفضل مؤسسات التعليم العالي، وقد تصدرت، كالعادة، الجامعات الناطقة بالإنجليزية قائمة الألف جامعة المنتقاة من 2500 مؤسسة، هي العدد الإجمالي الذي تم حصره في الترتيب.
فبقراءة متأنية لجداول التقرير نلاحظ استمرار جامعة هارفارد للسنة الثانية والعشرين على رأس أفضل مؤسسة جامعية في العالم، تليها في الترتيب ثمان جامعات أمريكية معروفة بريادتها العلمية والأكاديمية، سيما في مجال البحث العلمي، من قبيل: ستانفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبيركلي، وبرينستون، وكولومبيا، وشيكاغو، وجاءت بعدها جامعة باريس ساكلي (Paris sacley) في الرتبة 15، لتكون بذلك المؤسسة الأفضل في أوروبا القارية.
يُذكر أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات (Academic Ranking of world universities)، يصدر في شهر غشت كل عام، وقد دأبت الهيئة المستقلة المشرفة على إعداد التقرير على اعتماد ستة معايير مرجعية للتقييم والتصنيف، بما فيها عدد ميداليات أو جوائز نوبل وفيلدز، وعدد الباحثين الأكثر استشهادا بهم في تخصصاتهم، وعدد المنشورات في مجلتي “ساينس” (science)، و”نيتشر” (Nature).
ولأن هذا التصنيف يركز بشكل كير على البحث العلمي والإنتاج الأكاديمي، فقد تعرضت معاييره وطريقته في التقييم لبعض النقد من قبل بعض المؤسسات الجامعية في العالم، خلافا للتصنيفات الدولية الموازية له، والتي تركز، علاوة على البحث العلمي على معايير ومؤشرات أخرى، كما هو حال تصنيف “كيو إس” (QS)، الذي يولي اهتماما شديدا لمدى تقدير رجال الأعمال والعالم الأكاديمي للجامعات، وللطلبة المتخرجين الذين يطمحون لارتياد عالم المال والأعمال، وتلبية حاجيات السوق. أما تصنيف التايمز فيوجد في موقع بين شنغهاي وكيو إس، حيت يسعى أصحابه إلى إقامة توازن بين البحث العلمي والتدريس، أي تلقين المعارف.
غاب بلدنا المغرب، كالعادة، عن تصنيف الألف جامعة الأولى في العالم بحسب تقرير شنغهاي وهي نتيجة متوقعة، بل تحصيل حاصل، لأن المغرب ظل على الدوام منذ صدور أول نسخة من هذا التقرير خارج الترتيب، فقليلة هي الجامعات العربية التي دخلت بالتدريج دائرة التصنيف، في بعض دول الخليج العربي (المملكة العربية السعودية ولاحقا قطر والإمارات وعمان)، ومصر، وبشكل جد محدود ومتأخر تونس. لذلك، يعكس نصيب الجامعات العربية من ترتيب شنغهاي صورة بلدانها في مجالات التنمية الإنسانية، وتمويل البحث العلمي، والاستقلال الأكاديمي والمعرفي، والنزاهة الفكرية وحكامة التسيير والتدبير المالي للمؤسسات التعليمية.
إذا حصرنا التفكير في حالة المغرب وتساءلنا عن مصادر تفسير استعصاء دخول الجامعات المغربية قائمة الألف جامعة في العالم، حتى لا نقول 500، سيكون الجواب مباشرة ودون تردد أن نموذج التعليم العالي في بلدنا لم نمسك بعد بمفاتيح نجاحه، وتحويله إلى قاطرة حقيقية لخدمة بناء المجتمع والإنسان على كافة الأصعدة، وفي صدارتها تكوين المعرفة، وإعداد الكفاءات لتكون مرتبطة ببلدها، وامتلاك لسان مجتمعنا دون التفريط في اللغات الحية والمنتجة للعلم في العالم.
لقد سبقت الإشارة في أكثر من مقال ومناسبة، إلى تحليل مصادر غياب الجامعات المغربية، إلا النادر منها، عن التصنيفات الدولية للجامعات في العالم، ولأن الأوضاع بقيت على حالها، فإن الأسباب التي أوعزنا إليها واقع الجامعات تبقى صالحة للتفسير، ومنها على وجه التحديد التردد في معالجة ملف التعليم في شموليته، والتعليم العالي حصريا، بقدر جدي وصادق من المسؤولية والوضوح والإقدام. وفي الظن أن أول خطوة في هذا الباب أن نعتبر التعليم، وبشكل لا رجعة فيه، قضية إستراتيجية ومصيرية للبلاد والعباد، وأن نبتعد في معالجته وإصلاحه عن “السياسة” المُضللة، كما حصل في مجمل التجارب السابقة، حيث تحول ملف مهم ومصيري وخطير مثل التعليم إلى موضوع للمزايدات، وإرضاء الخواطر، وإقحام من يصلح لإصلاحه ومن لا يصلح.
فكل التجارب التي نجحت في إرساء نموذج تعليمي فعال، ومنتج حقيقي للمعرفة، ومكون للكفاءات اللازمة لخدمة البلاد، لم تُسند مهمة بناء نموذج تعليمي لمن لا صلة لهم به، بغض النظر عن الأسباب كيفما كانت سياسية أو جهوية أو لغوية، أو مبنية على الوجاهة والمحسوبية. ثم إن اختيار القادرين على بناء نموذج تعليمي ناجح، ليسوا منزهين عن المساءلة والمحاسبة، بل يعتبر تقييم إنجازاتهم لازمة ضرورية لتقييم نسبة ما نجحوا وما لم ينجحوا فيه. وهو، مع الأسف، ما لم يتحقق في تجارب إصلاح التعليم في المغرب بشكل كبير ودائم، فقد صُرفت أموال طائلة من جيوب دافعي الضرائب، وانحرفت في أغلبها عن الأهداف المسطّرة لها، ولم يتعرض المسؤولون عن الانحراف للمساءلة والمحاسبة، بل هناك منهم ما تمت ترقيتهم إلى مناصب أعلى وحصيلة فشلهم وتبديدهم للمال العام شاهدة عليهم.
ثم إن إصلاح التعليم، والتعليم العالي على وجه الخصوص، يتعذر تحقيقه بدون وجود رؤية، ترسم أهداف النموذج، ومراحل إنجازه، والكلفة المالية اللازمة له، ومصادر تكوين هده الكلفة، علاوة على المؤسسات الرقابية التي تسهر على فرض احترف صرف المقدرات المالية لبناء النموذج، باعتبارها مالا عاما يحظى بالاحترام والقدسية، بكل نزاهة وشفافية ومسؤولية، حتى لا يضيع البناء ويصاب بالتيهان في سراديب الفساد وغرفه المظلمة.
فالخلاصة أن المغرب جرب مجمل النماذج، وأوفد مبعوثين وخبراء لمعاينة التجارب في مواقع نجاحها، وقد صرف من أجل ذلك أموالا طائلة، فلا يحتاج اليوم لمعرفة أو الإطلاع على التجارب، بل يحتاج لأمرين أساسيين وإجباريين بدونهما ستظل البلاد تدور في حلقة مفرغة؛ أولهما إرادة اختيار الكفاءات لبناء نموذج التعليم الناجح، بنزاهة وبدون توجس أو محسوبية، وتوطين ثقافة المساءلة والمحاسبة بحزم وبدون استهلاك للشعارات.. نحتاج لقدوة البناء، واحترام قدسية المال العام بالقانون ونزاهة المؤسسات ذات العلاقة.