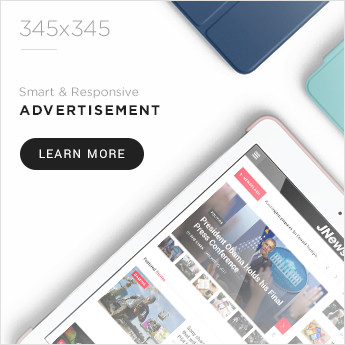أمل عكاشة
برزت في أوساط المجتمع المغربي، الأسبوع الأخير، وخاصة في فضائه الافتراضي، مطالب ملحة بتخفيض سعر البنزين والغازوال، مقترنة بمطلب أخير مبطن، ينادي بإرحل أخنوش! ولا شك أن “الهاشتاغات” الثلاث، الواصلة لمعدلات عالية من المشاركة، تجسد نبضا مجتمعيا حقيقيا، فلا غرو أن الكثير جدا ممن يشاركونه ويروّجون له، يجدون فيه متنفسا للتعبير عن غضب واستنكار، تقاعست عنه باقي القوى الاجتماعية. لكن هذا الأمر، لا يمنع من التفكير أو حتى استحضار محرك ودافع “الحركة الاحتجاجية” الافتراضية، خاصة وأنه اليوم، أصبح الفضاء الرقمي تربة خصبة لتحريك وتوجيه الرأي العام، ويكفي هنا التذكير بما حصل عند محاولة الانقلاب على “أردوغان” سنة 2016.
وتعريجا على ما حصل لمجموعة من الدول العربية، جراء ما يعرف “بالحرب الإعلامية”، نستحضر الخطورة الجسيمة والبالغة لما يمكن أن تحمله من تبعات ومنائب، إذ من خصالها تخفي الجهاز المحرك والعقل المدبر، في مقابل تعاطف وتهيج جيوش من أصحاب الحق المشروع، ومع توسيع المشاركة وانخراط من يطلق عليهم “المؤثرين” إلى جانب بعض من أصحاب “مصداقية” في مجالات تخصصهم، تصبح “الحركة” لها قوة حماسية منقطعة النظير، يصعب إحجام جماحها أو حتى ضمان مسارها، وهنا تحضر الخطورة، حيث تصبح العاطفة هي المحرك.
ولسنا نحاجج في مصداقية أو أحقية المطالب، فلا ينازع عاقل في ضرورة تخفيض أسعار مواد الطاقة وفق ما يمليه منطق السوق من عرض وطلب، فإذا كان سعر البرميل في حدود 93 دولارا، فهذا يجب أن ينعكس مباشرة على سعر اللتر، وإلا سنكون أمام اغتناء غير مشروع لصالح شركات المحروقات، وإذا كانت الوضعية السابقة عرت عن هشاشة نظامنا الاقتصادي المحكوم بالتبعية المفرطة للاقتصاد العالمي، فإن المستقبل يفرض علينا التعلم من أخطاء الماضي، والحلول متوفرة؛ حيث يمكن إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو الاقتصادات المنتجة للقيمة المضافة، التي تُغلب المصلحة الوطنية على مصالح الرأسمال.. وكذلك تفعيل آليات التوازن الداخلية، من خلال التعديل في النظام الجبائي والضرائبي.. وغيرها كثير من الحلول، إذ تكفي الإرادة الخالصة لابتداع اقتصاد مغربي قوي.
وكما هو معلوم، فإن أي تغيير يواجه ما يعرف “بجيوب المقاومة”، التي تخشى ضياع امتيازاتها، ولو بحملة افتراضية، فالريع عملة واحدة، وكخرجة بنكيران الأخيرة، يُنتظر بروز العديد ممن سيسفه الحق المشروع، ومن سيحاول توجيه النقاش في غير الصالح العام..
وعودة إلى موضوع “الحملة الإعلامية” وإلى الأسئلة التي يجب طرحها، فإذا كان الفضاء الافتراضي أسهل مكان للتعبير عن التساؤل والغضب والاستنكار، حيث لا جزاء ولا عقاب، بل عنترية وبطولة مزيفة، فلماذا لم يعبر عن الغضب لا عند أول ولا ثاني ولا حتى ثالث قفزة في أثمنة المحروقات؟ لماذا لم تُستنكر الزيادة في كل الأسعار، الأساسية منها والثانوية؟ لماذا لم نشهد هذا الإحتقان عند الزيادة وظهر عند المطالبة بالنقصان؟ لماذا نثور مع منطق المطالبة بالمراعاة وتحسين الأوضاع في حين أن رفض الزيادة مرّ مرور الكرام؟ ولماذا لم تلاقي الأصوات الرصينة المنادية بحلول جدية وعملية نفس الاهتمام والمساندة؟ أم أن عذر الحرب الروسية الأوكرانية كان كافيا لتصبح نيران الغلاء بردا وسلاما !
أسئلة أخرى تتناسل بإعمال نفس المنطق، الذي لا يستبعد أطروحة التوجيه، في زمن تجاوز فيه الإعلام مجال السلطة الرابعة، إلى محرك للاستقرار والفوضى، فلماذا كان دور الانتقاد في عهد الحكومتين السابقتين في أوج نشاطه؟ مقابل ركود وسبات طوال فترة حكومة أخنوش؟ إن مجرد استحضار هذه المفارقة، يوحي بضرورة البحث وطرح أسئلة أكثر، وهنا ليس للنظر في الجدوى والنتيجة، وإنما لتقصي الدافع والمحفز.
وفي هذا الصدد، ربما تسمع صوت مواطن يقول؛ “أنا لا تعنيني كل هذه الحسابات والتأويلات، فالغلاء أمر واقع والجيب لم يعد يتحمل، أريد الحل مهما كانت الوسيلة”، بالفعل، فالغلاء فتك بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولا بد من إيجاد الحلول، وهنا تبرز حقيقة دولة المؤسسات، التي عليها أن تسمع لنبض الشارع وتتجاوب معه، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أولى مسؤولياتها.
الوسيلة إذن هي الفيصل في تحديد الطريق، ومنهج المؤسسات سالك وآمن، فلنعالج خلل الأحزاب ولتمارس أدوارها، ولنضع اليد على شلل النقابات ولنقوّمه، وليقم البرلمان بدوره الرقابي وليعكس واقع الأقاليم في قرارات المركز، ولنُقدم على القضاء لرسم طريق العدل، وليُخلص المجتمع المدني للصالح العام.. فطريق الإصلاح شاقة وطويلة، ولا علاقة لها بمنطق “نسخ لصق”.