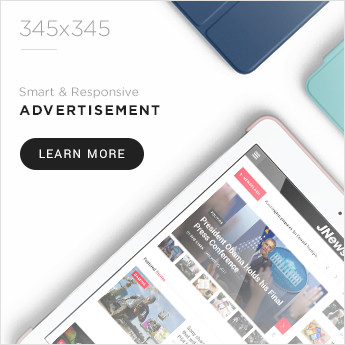عقب استقلال المغرب سنة 1956 عن الإدارة الفرنسية المباشرة، كان البلد في يعرف ما يمكن تسميته حالة ارتباك في الوضع السياسي القائم، فالقصر، ممثلا بالملك محمد الخامس، لم يكن على دراية تامة بأساليب الحكم، أما التشكيلات السياسية التي ظهرت في البلد، سواء خلال فترة الحماية أو بعدها، فقد كانت خطاباتها السياسية لا تزال قيد التشكل و التكوين في خضم تنافس محتدم بين أفكار تقليدية و أخرى ذات طابع “ثوري” تأثرت لحد ما بالخطابات الرنانة التي كانت سائدة آنذاك في المشرق العربي كالقومية الناصرية و الاشتراكية بتفسيراتهما الضبابية لواقع الأزمة التي تعيشها البلدان العربية.
لكن، مع وفاة محمد الخامس و تولي ابنه الحسن الثاني زمام الحكم، عرف المغرب صراعات حادة بين القصر من جهة، و بعض التنظيمات السياسية ذات المنحى اليساري بأبعاده المختلفة، من جهة ثانية، و قد شكلت هذه الصراعات، بالنسبة للحسن الثاني، الذي درس في كليات الحقوق و القانون، درسا تطبيقيا بليغا استفاد منه بشكل ممتاز حيث عمل منذ البداية على تقزيم الدور المتنامي للأحزاب “الثورية” و تمكين القصر من استعادة الدور المركزي في الحكم، وذلك قبل أن يتمكن من منح المغرب، سنتين بعد توليه السلطة، أول دستور يكرس دور الملك كجهة مركزية في إعداد السياسات العامة و تنفيذها.
ولعل أهم جديد أتى به دستور 62 “الممنوح”، على الأقل بالنسبة للملك، هو منع سياسة “الحزب الوحيد”، و هكذا استطاع الحسن الثاني عبر هذه التقنية الدستورية احتكار “الأحادية” لصالح مؤسسة الملك بعدما تمكن من نفيها عن أي “مؤسسة حزبية” يُحتمل أن تستحوذ على مزايا الحكم و تهيمن على المشهد السياسي العام.
لكن الحسن الثاني، خريج كلية الحقوق، عمل مدة طويلة للإستفادة من الواقع الدستوري المستحدث ، بحيث بذل ما في جهده لفرض واقع التعددية الحزبية، سواء كان ذلك بنقل الحزب الواحد من صيغته “الواحدة” إلى واقع “الثنائية”، أو عبر تشجيع صناعة أحزاب “جديدة”، ذلك أن الملك وَعى مبكرا الدور “الهام” للأحزاب السياسية في المشهد السياسي العام، على الأقل من الناحية النظرية، و أنه لا غِنى للقصر عنها إذا كانت له رغبة الاستمرار و تبوأ مكان الصدارة في مؤسسات الحكم.
“الفلسفة الحسنية” في أساليب الحكم السلطاني، لم تنته مع وفاة الحسن الثاني، بل طورت نفسها و تفاعلت مع الأوضاع الجديدة التي أعلن عنها الملك محمد السادس غداة توليه العرش ، تطوير “الفلسفة الحسنية” اتخذ، من خلال مضامينه، بعدا مغايرا لما كان عليه الوضع في بداية حكم الحسن الثاني، فإذا كان الأخير ابتعد عن اليسار نحو الوسط خلال هذه الفترة، فإن خلفه عمل من أجل المصالحة مع “اليسار”، لكن دون إقصاء “اليمين”.
في هذا السياق، حدث ميلاد حزب، جديد في حينه، و اختار لنفسه إسما بملامح تحيل على خاصية “الوسطية”، فقد قدم نفسه كحزب لا يضع قطيعة بين مفهومي “الأصالة” و ” المعاصرة” و أنه لا يمانع في الجمع بينهما ضمن تشكيل واحد يضمن ممارسة الحزب سياسته دون حرج.
و بالفعل، تشكلت النواة الأولى لهذا الحزب من خلال عديد المناضلين ممن كانوا سباقين للإيمان بعقيدة “اليسار الديموقراطي”، و كان في “مجموعتهم” هاته، رجل يحمل اسم ” الياس العماري”، و هو رجل ريفي نذر حياته للنضال النقابي السري في صفوف التلاميذ، و للنضال السياسي في اليسار السري منذ أواسط الثمانينات.
الرجل، انتقل فيما بعد لتطوير مساره السياسي في هرمية الحزب الجديد قبل أن يتوجه سريعا بتقلد مهام أمانته العامة محملا بإرثه النضالي.لكن المفاجأة المتوقعة، التي لم يتمكن العماري من تفادي حدوثها، هي أن الحزب المشكل على مبدأ “ثنائية الأضلاع” أصيب بالتشوه، كنتيجة للامتداد الأوسع و الأضخم لـــ”ضلع اليمين” على حساب تقلص و انكماش”ضلع اليسار”، و قد حاول إلياس، مستعينا بمركزه و أدبياته السياسية، أن يحفظ لليسار هيبته و أن يحد من امتداد اليمين داخل حزبه، أملا في “ترويضه” بطريقة لا غالب و لا مغلوب، لكن المفاجأة التي صدمت العماري لم تكن سوى اكتشافه بأن ما كان يعتبره “يمينا سياسيا” داخل الحزب لم يكن سوى كتلة من الانتهازيين.
و كان هذا درسا بليغا في علم السياسة المغربية “المعاصرة”، لكنه أيضا ذلك الدرس الذي أوقف مسيرة هذا الرجل، و لعل وقوع البام تحت وصاية “عالِم الجوارب” غير الموهوب في السياسة، في حاجة، ولو إلى النزر اليسير من الحكمة التي أسسها إلياس العماري، من أجل إعادة الهيبة و الوقار إلى العمل الحزبي و نفض “رائحة الجوارب” عنه، حتى لا يقع في “فضيحة التقاشر”.