يكــــاد يجمع المفكرون و رجال القانون العالمون بتاريخ و تطــور المؤسسات السياسية، على فكرة محورية تقول في مجملها بــــأن مؤسسة سياسية كــــبرى مثل “الدولة” لم تكن لتنشأ لولا حصول تعاقد بين الناس، وهكذا نجد مفكرا مثل طومـاس هوبز، على سبيل المثال، يقول إن “القانون الطبيعي حتَّم على الأفراد البحثَ عن مَخْرَج من حالة التعاسة التي كانوا عليها في مرحلة الفطرة، ما دفعهم لإبرام عقدٍ بِإنشاء “الدولة”، عقد تنازلوا بموجبه عن حقوقهم ليضعوها في يد جهة تتركز لديها السلطة، و ذلك مقابل شرط وحيد هو “حصولهم على الأمن”
بالرغم من تعدد نظريات المفكرين بخصوص الإجابة عن سؤال : كيف نشأت الدولة؟ و بصرف النظر عن النقاشات الكثيفة التي دارت حول طبيعة أطراف “العقد الاجتماعي ” المؤسس لهذه الدولة و مضمون هذا العقد و شروط فسخه، وغير ذلك من الأسئلة النظرية، رغم ذلك، فقد حصل اتفاق على أن الهدف المركزي يجب أن يــكون : “إنشاء الدولة” بشكل يضمن لها الخروج في أفضل الصيغ لتكون “قادرة على تلبية طموحات المحكومين، وتنطوي في ذات الوقت على الآليات الكفيلة بتمكين الحكومة المنتخبة من إدارة شــؤون الدولة بأعلى قدر من الكفاءة”.
بعيدا عن المناظرات الفكرية المرتبطة بنظرية “العقد الاجتماعي” و تحولاتها عبر التاريخ المعاصر، لا بد من الإقرار بأن نشوء الدولة قد تم في أروبا، وتحديدا في النصف الغربي من هذه القارة العجوز، و منها انتقل “المفهوم الحديث للدولة” إلى بقاع أخرى من العالم، سواء أتمَّ ذلك عبر طريق الاقتداء، أو عبر التوسع الاستعماري الذي اتخذته الدول الجديدة.
و بالطبع، فالمغرب، رغم كونه عرف أشكالا يمكن وصفها بالـــ”ماقبل حداثية” فيما يخص مفهوم الدولة، إلا أنه يعتبر كذلك موضوعا لنشوء الدولة عبر وسائط الاستعمار، و هو استعمار صيغ في شكله القانوني الملائم ليصبح معه “حماية” بدل احتلال، و لذلك فإن الشكل الحديث للدولة المغربية لم يظهر للوجود إلا مع خروج “الحامي” الأجنبي و إعلان البلد استقلاله.وما دام نشوء المغرب كدولة حديثة لم يتحقق إلا قبل نحو نصف قرن أو أكثر بقليل، فإن السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه الآن يتعلق بماهية و طبيعة التصورات التي يمتلكها المغاربة إزاء كائن سياسي اسمه “المغرب”؟
لقد تشكل لدى المغاربة منذ السنوات الأولى للاستقلال، و بمختلف فئاتهم و عقائدهم و طبقاتهم، مفهوم يعتقد بأن الدولة كائن قوي و خارق، و أن بإمكانه صناعة المستحيل إن اقتضت الضرورة ذلك، و بلغ الاعتقاد بهذا المفهوم درجة أصبح معها بعض “المواطنين” يجسدون الدولة،كعنوان للقوة، في مجرد فرد تافه فقط لأنه ينتمي “للدولة” !
لا شك أن درجة حدة هذا المفهوم قد تراجع الاعتقاد بها كثيرا لدى عامة الناس، لاعتبارات حقوقية و معرفية، لكنه تغير بالنسبة لكثيرين منهم، لاسيما أولئك الذين يصنفون ذواتهم في دائرة “الدولة” أو في حواشيها، إذ تحول اعتقاد هؤلاء و تطور بشكل سريع، إذ لم تعد الدولة لديهم مجرد كائن “مرعب” بل هي أيضا، من جانب آخر، كائن يفتح سبل الاغتناء السريع أمام الشخص المنتمي لهذه الدولة، بل إنها قد تكون أيضا مصدرا مباشرا للاغتناء و لو كان ذلك عبر مجرد انتماء تافه لمؤسسة من مؤسساتها العامة.و هكذا تشكلت، في “الفكر الإدارويّ” المحلي، نظرية جديدة تقوم على مبدأ الإكثار من النفقات التي يخولها القانون “المكتوب” لرعاية مصالح العموم، وذلك قبل العمل عل “استعادة” هذه النفقات نحو الحساب “الخصوصي”، وهي نظرية بسيطة لكنها في نفس الوقت عملية و تحقق “الفائدة الخصوصية” للصوص و المختلسين، إنها بكل تأكيد نظرية لصوصية ساعدت بشكل مطلق و غير خاضع للرقابة الفعلية في توسيع “دوائر السرقة غير الموصوفة ” !
محمد العطلاتي
















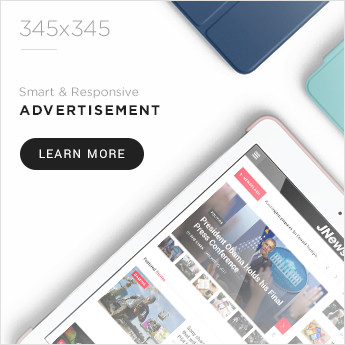



Thank you for any other informative website. Where else could I am getting that kind of info written in such a perfect approach? I have a mission that I’m simply now operating on, and I have been on the glance out for such information.