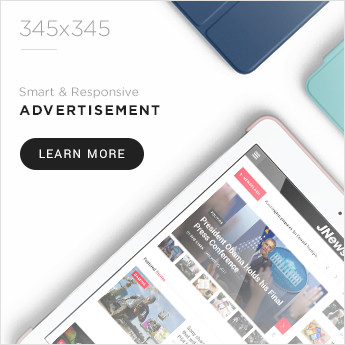مع حلول شهر مارس من كل عام، يتذكر العالم المرأة، وحقوقها، ونضالها من أجل المساواة الكاملة مع الرجل، في كل مجالات الحياة وتكاليفها الأسرية والمهنية.
ولو أن المرأة الشرقية، والمغربية بالذات، توجد على مسافة “ضوئية” من منجزات المرأة الغربية التي استطاعت أن تحدث تغيرا ولو غير تام في العقليات المجتمعية، وفي نظرة المجتمع إلى المرأة التي اقتحمت، في النهاية، جل المجالات الذكورية، دون اعتراض “عدواني”، ودون “خلفيات” تراثية أو عرفية، أو دينية، إلا أن الحركات النسائية المغربية واعية بصعوبة النضال الذي تخوضه وأن عليها أن تستمر في نضالها
بالرغم من أن الهدف لا زال بعيدا.
ولعل من أهم القضايا “الجهادية” في مجال الحقوق والواجبات، التي تناضل المرأة المغربية، والتي طغت على “الكوطا” الانتخابية، واللوائح الوطنية والجهوية وقضايا انتخابية أخري، هي قضيةُ المساواة في الإرث، وهي قضية لا تريد لها الذكورية المدعمة من فقهاء بعقول متحجرة ، أن تطفو على السطح، وتكتسب المزيد من الدعم، من طرف العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية، والثقافية والأهلية، وتصبح مادة إجماع وطني، ويرتفع ما تعتبره النساء حيفا وظلما واستبدادا ذكوريا وطغيانا.
إن تسلح أعداء المساواة في الإرث ب “القوامة” أمر فقد السند الذي اعتمد عليه في السابق. إنه أمر مادي صرف، وبه مجلبة للربح والثروة، ولذا فإنهم يتشبثون بمسألة “حظ الأنثيين”، حتى وإن لم يكن بينهم وبين الدين الإسلامي والقرآن الكريم، “لا خيرٌ ولا إحسان”.. !.
والكل يعلم أن مادة الإرث يتدخل فيها الدين والمال والأعراف، وتكون المرأة الحلقة الضعيفة في هذه العملية، حيث إن نساء كثيرات تعرضن، وأبناءهن، وبناتهم للتشرد والضياع، بعد أنفة وعز قبل وفاة الزوج أو الوالد المعيل، لينقضّ غرباء ٌعلى “التركة” ممن لا يخشون الله ولا يخافون العاقبة، ويكون مصيرهم جميعا الفقر والتشرد والضياع.
ويعلم الجميع أن تشبث فقهاء التزمت لا يريدون النظر بواقعية إلى الأوضاع الحالية للمجتمعات المسلمة، وينتبهوا إلى أن “القوامة” سقطت وصارت من ذكريات الجاهلية الأولى. ولعل الأوضاع انقلبت ، بعد أن اقتحمت النساء سوق الشغل، وأصبحن يعلن أسرهن وينفقن على أطفال الأسرة ، أحيانا، على الزوج نفسه، في حالة عجزه عن القيام بوظيفته، و”قوامته” وبالتالي فقد صار واجبا مراجعة النصوص بغاية ملاءمة المفاهيم الاجتماعية مع التطورات الهائلة التي شهدتها البشرية، خلال الألفية الثانية وبداية الثالثة، علما وثقافة ومفاهيم، ساعدت تكنولوجية الاتصالات الحديثة، على انتشارها وتبنيها على نطاق عالمي.
حقيقة إن الأديان السماوية، والإسلام بوجه خاص، جاء لإصلاح المجتمعات البشرية، ووضعها على صراط التطور بوعي كامل، إلا أن هذا التطور أصبح يفرض مراجعة النصوص بالنسبة لمجتمعات تساوت فيها مسؤوليات الرجل والمرأة، إن لم تكن مسؤوليات المرأة قد فاقت مسؤوليات الرجل في العديد من مجالات الحياة العلمية والمهنية واكتساب الثروة.
وبينما اتخذت المجتمعات في جهات أخرى من الكون، حلا بخصوص مسألة الميراث ينبني على الوصية الحرة للهالك، قسّم الميراث المجتمعات الإسلامية إلى فئتين: فئة متنورين تطالب بالمساواة وفئة منغلقة متحجرة تتمسك بمسألة حظ الذكر مقابل حظ الأنثيين. وهو حكم يركب عليه المؤمنون والملحدون سواء بسواء، بدافع الطمع والجشع، والظلم، من أجل الاستيلاء على حقوق تعود لورثة شرعيين، يستفيدون من جهد الهالك قيد حياته، من أجل إسعاد أهله وأبنائه بعد رحيله، إلا أن “فتحة” في فقه المواريث، تمكنهم من الوصول إلى تركة الهالك، للاستفادة مما يسمونه “حق الشرع”، من باب الحق في التركة أو “التعصيب” الظالم، الذي يراد به “معاقبة” الرجل الذي لم ينجب سوى الإناث (؟)…. وكثيرا ما يتحايلون على “القواعد” ويستولون على التركة، ويدفعون بالورثة الشرعيين إلى التشرد والضياع.
فهل يقبل الشرع بهذه الحالات اللاإنسانية، وغيرها كثير مما تتناقله الألسن، وما تردده مواقع الإعلام كل صباح، والحال أن الإسلام دين الحق وأن الله سبحانه وتعالى هو الحق والعدل والرحمة ….وإلا ، فكيف بـالفقهاء يغضون الطرف، عنوة، عن كل هذه المظالم، ويقفون عند حكم يعلمون أن سلبياته تتجاوز إيجابياته المنتفية أصلا، حكم قابل للاجتهاد وفقا لمنطق الدين، واعتبارا للتطورات الهائلة التي شهدتها المجتمعات الإنسانية……إلا أن تكون خساسة من خساسات ذلك الإنسان “الظلوم الجهول”…… !!!!.
سمية أمغار