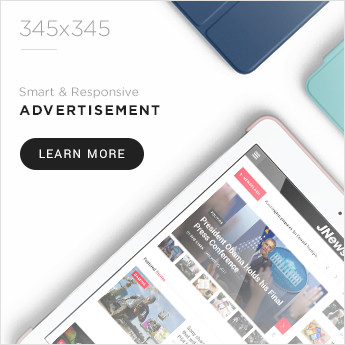سلسلة تعريفية واقعية تلقي الضوء على بعض الكتاب والمفكرين والباحثين والمبدعين في شتى مجالات العلوم والمعرفة ، لإبراز لمحات من حياتهم الشخصية والعلمية ، والتعريف بمؤلفاتهم وأحدث إصداراتهم التي تشهد بعمق معرفتهم ، وموسوعية علمهم ، تتنوع هذه الشخصيات بين أكاديمية وعلمية وأدبية.
سلسلة تعريفية في قالب حواري تمد جسور التلاقح بين المفكرين وبني عصرهم ، وبين المفكرين وطبقة قرائهم ، وتطلعهم على مسار إنتاجهم وأهم أعمالهم وآخر إصداراتهم.
في هذه الحلقة نستضيف فيها الكاتبة والمترجمة الأستاذة الدكتورة : سناء الشعيري.
بادئ ذي البدئ ، نرحب بك ضيفة عزيزة في هذه الفسحة الحوارية من سلسلة ” في ضيافة كاتب ” ، وأول ما نود أن نستهل به هذا الحوار التعرف عليك من خلال مسيرتك الحياتية والمهنية والعلمية ؟ .
بسم الله الرحمان الرحيم فاتحة كل خير وتمام كل نعمة ، وألف صلاة وسلام على سيدنا محمد ، النبي الأمين ، أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة ونصح الأمة ، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد…
بداية ، أتقدم بالشكر الجزيل للقَيّمِ على هذا الركن الجميل من جريدة طنجة العتيدة ، السيد عمر قرباش ، وأسجل له بمداد العرفان جميل الشكر وعظيم الامتنان على سعة صدره ، وإصراره الشديد على أن أنضم إلى كوكبة المشاركين في هذا الحيز العلمي المنير، الذي لا يرتاده سوى صفوة الناس من العلماء والمفكرين والأدباء والمترجمين… فشكر الله له حسن الظن فينا. ونتمنى أن تكون مشاركتنا هاته لبنة جديدة تنضاف الى صرح الحيز الذي خصصته مشكورة جريدة طنجة ، للكتابات النسائية ، وللحضور النسوي الذي لايستقيم المشهد الثقافي إلى بوجوده وحضوره القوي والمتميز.
أنتقل الآن لأُحدث القارئ الكريم عن مسيرتي العلمية والأكادمية ، ومشواري الدراسي الطويل. وسأعرج بعدها للحديث عن ذكريات عزيزة ، سأنفض عنها الغبار لمكانتها في نفسي وفضلها الكبير في ثبوت القدم ورسوخها على أرضية الترجمة والكتابة الإبداعية .
إسمي الكامل سناء الشعيري ، من مواليد دجنبر 1975 بمدينة طنجة ، أو مدينة البوغاز كما يحلو للبعض تسميتها. تزامنت سنة ميلادي مع حدث وطني ترددت أصداؤه في جل ربوع المملكة . فكانت الوالدة أطال الله في عمرها تجيب دائما كل من يسألها عن سنة ميلادي، أن ابنتها البكر ازدادت سنة المسيرة الخضراء . والواضح أن رمزية هذا الحدث الكبير الذي لا ينسى تاريخه كل المغاربة ، كانت ملاذ كل الأمهات اللواتي لا يضبطن يوم وشهر ولادة الأبناء، فيكتفين بذكر لفظ المسيرة الخضراء باعتباره حدثا دلاليا يوثق لمرحلة متجذرة في الذاكرة الجماعية .
ترعرعت في بيت بسيط بحي كان يُعرف فيما مضى بإسم – زنقة بن شمول- وهو حي تعايشت فيه قديما أقليات اليهود والنصارى والمسلمون المغاربة ، وتشهد على ذلك إلى حدود الساعة هندسة المباني التي كانوا يقطنونها ، فبيوتاتهم كانت فسيحة ، تعلو بعضها تماثيل لا تزال إلى يومنا هذا شاخصة أبصارها ، تذكرنا بماض قد ولى…
مرت الطفولة في مبنى مؤلف من ثلاث طوابق، تسكنه خمس أسر، فذُقت في أيام الصبا حلاوة العيش بين الأهل والجيران ، وفتحت عيني على مشهد الأبواب المفتوحة ، وأمسيات الشاي. ووقفت على أشكال التضامن والتكافل الإنساني ، حيث المساندة ساعة الشدة ، وتقديم يد العون ساعة القرح ، والفرح والسرور في أيام الآعياد والمناسبات ، وأطباق الحلوى المتبادلة… فيا لها من أيام افتقدناها مع ضجيج الروتين اليومي وصخبه ، وكل ما يصحبه من ضغوطات وجري ولهث خلف أمور أفسدت علينا بهجة الحياة.
كانت أسر الحي من الطبقة المتوسطةّ ، موظفون في سلك التعليم ، تجار صغار، حرفيون وعمال ومستخدمون…الكل يعمل من أجل لقمة العيش ، والكل يرسل أبناءه للتمدرس بغية التعلم والإرتقاء في مدارج التحصيل المعرفي والأخلاقي.
كنت ولازلت أعتبر والدي بارك الله له في صحته وعافيته ، وأطال الله له في عمره ، رجلا حداثيا بالمفهوم الجميل للكلمة ، وذلك لإصراره على أن تستفيد بناته الأربع مثل ولده الوحيد على نفس مستوى التعليم ، فكان رغم تواضع إمكانياته لا يدخر جهدا في توفير كل ما يلزم المسار الدراسي من أدوات ، وتغطية مصاريف الدروس الخصوصية إذا دعت الضرورة الى ذلك ، وتلقين الأبجديات الأولى للقراءة والكتابة .
كان الوالد رجلا حافظا لكتاب الله ، تلقى تكوينه القرآني في كتاتيب قبيلة أنجرة، وكان صوته دائما يصدح بتلاوة الذكر الحكيم في البيت. كان يُوصينا دائما وأبدا بالنهل من نبع مكارم الأخلاق. فأخذت عنه جزاه الله خيرا ، خصال التسامح ، والعفو والإيثار والإحترام والكلمة الطيبة… فلازال يساندني ، حتى أتممت دراستي ، يرافقني أينما حللت وارتحلت ، فيصحبني في سفرياتي العلمية ، فتراه يجلس في الصفوف الأمامية يبتسم ويُصغي ، ويُصفق ما شاء الله له أن يصفق وهو الذي لا يفقه شيئا من اللغة الإسبانية التي كنت أحاضر بها ، وأُخاطب بها جمهور الحاضرين.
وحتى لا أبخس الوالدة الحبيبة حقها ودورها في التنشئة والتربية ، فلها يعود الفضل أولا وآخرا في استقرار الفضاء الأسري الذي كانت تسهر عليه بجد وعناء. فكانت تعفيني من كل الأعباء المنزلية صغيرها أو كبيرها ، لأنكب فقط على دراستي. وساعدتها عفويتها وفطرتها على إمدادنا بتربية بسيطة أثمرت عن أبناء والحمد لله ، يتمتعون بحس عال من المسؤلية وتدبير الشأن الشخصي.
تلقيت تعليمي الإبتدائي ، والإعدادي والثانوي بالمدارس العمومية ، حيث الأقسام المكتظة ، والمناهج الكلاسكية… فكانت الإنطلاقة من مدرسة الحسن الأول بحي خوصافات ، ثم انتقلت إلى إعدادية الزيتونة ومنها الى ثانوية زينب النفزاوية .
بعد النجاح في الباكلوريا ، توجهت إلى مدينة تطوان لمتابعة دراستي العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ، شعبة اللغة الإسبانية وآدابها. قضيت أربع سنوات في رحاب هذه الكلية ، وكلل الله تعالي مجهوداتي بالنجاح ، وحصلت على الإجازة سنة 1997.
في السنة الموالية اجتزت مبارة ولوج المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل ، فَوُفِقت بفضل الله ومِنته ، وتخرجت بميزة حسن جدا ، فقدر الله لي أن أكون الأُولى على الدُفعة ، ونال بحثي لتلك السنة جائزة أحسن بحث تربوي في مجال ديداكتيك اللغة.
وعن سن يُقارب الثالث والعشرين دخلت القسم ، وشرعت أشق مشواري المهني كأستاذة للغة الإسبانية في سلك التعليم الثانوي التأهيلي بمدينة القصر الكبير التي درّست بها مدة سبع سنوات.
ومنذ السنوات الأولى في العمل ، قررت متابعة دراستي العليا، فتسجلت في سلك دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، والتحقت بمدينة الرباط لإتمام الدراسة ، وكانت لي حظوة التسجيل في وحدة البحث والتكوين المسماة ب: الأندلس: دراسات متعددة الإختصاصات التي كانت تدير شؤونها، بمعية طاقم تربوي عريض ، الأستاذة الفاضلة الدكتورة أمامة عواد ، سفيرة المغرب حاليا بدولة بانما بأمريكا الجنوبية.
أتذكر أن هذه السنوات لم تكن سهلة البتة ، ففيها كنت أزاوج بين الدراسة والعمل، وتكاثفت سفرياتي بين مدن إقامتي ودراستي وعملي، وتكاثرت زيارات المكتبات ، وتوالت أيام البحث صعبة مضنية ، لكنها انتهت بتبوئي، والحمد لله ، للرتبة الأولى على الدُفعة للمرة الثانية ، وحصلت على إثر هذا النجاح على منحة الإستحقاق التي سافرت بموجبها إلى الديار الإسبانية ، وبالتحديد إلى بلدية ألكلا دي هيناريس بالعاصمة مدريد للإطلاع على جديد البحث في معهد الدراسات الأندلسية والسفردية .
قد يطول الحديث عن المسار الدراسي الذي يفني فيه المرء باكورة شبابه ، لكن العبرة بالخواتم كما يقال ، وسر النجاح يكمن بالأساس في الإجتهاد ، والإخلاص ، والعزيمة الصادقة ، والإرادة القوية ، والله دائما وأبدا من وراء القصد .
بعد مرحلة السلك الثالث ، تسجلت بسلك الدكتوراه بنفس الكلية بالرباط ، واشتغلت على موضوع ” صورة المرأة الأندلسية في عهد ملوك الطوائف ” تحت إشراف الأستاذين الكريمين : الأستاذ امحمد بن عبود من كلية الآداب بتطوان ، والأستاذة أمامة عواد من كلية الآداب بالرباط . وفي مارس 2008 ناقشت أطروحتي ، ونلت درجة مشرف جدا مع توصية بالنشر. وبهذا الفصل الأخير من مسلسل المسار الدراسي أكون قد أسدلت الستار على مرحلة ندية أسست لمرحلة مقبلة قوامها البحث المتخصص والنشر الدؤوب.
لايفوتني التذكير في هذا المقام الكريم ، بأن سنوات العمل بالسلك الثانوي كانت حافلة بالتجارب الإيجابية مع تلاميذتي الأعزاء. فكنت إلى جانب إعداد وإلقاء الدروس ، والتحضير للإمتحانات ، أساهم في الإشعاع الثقافي للمؤسسة ، فكنت أنظّم عروضا مسرحية لفائدة التلاميذ، وأمسيات غنائية احتفالية باللغة الإسبانية… ونَشرتُ تجارب ميدانية لوحدات ديداكتيكية صدرت في دفاتر الرباط ، وهي منشورات تابعة للمستشارية الثقافية لسفارة إسبانيا بالرباط . وحصلت بعدها على ثلاث جوائز تربوية قيمة (جائزة أورتيغاإي كاسيط 2002 ، جائزة غارسيا لوركا2003 ، جائزة ماريا ثمبرانو) من نفس الهيئة الإسبانية التي كانت تنظم هذه الجوائز بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. لم يقف الأمر عند هذا فحسب ، بل استفدت كذلك خلال هذه الفترة من منح تكوينية في أرقى الجامعات الإسبانية ، للإطلاع على جديد المناهج في تدريس اللغة الإسبانية كلغة أجنبية ثانية بالبلاد ، فشددت الرحال إلى غرناطة إلى كلية علوم التربية ، ثم الى معهد اللغات الحية بنفس المدينة . وجامعة ميننديث بيلايو بمدينة كوينكا، وجامعة سلامانكا العريقة ، فكنت في كل مرة أسبر أغوار بحر اللغة الإسبانية ، وأخرج منه بدرر نفيسة تفيد الناشئة المغربية. فاللهم تقبل منا خالص أعمالنا.
يتبع …
عمر محمد قرباش