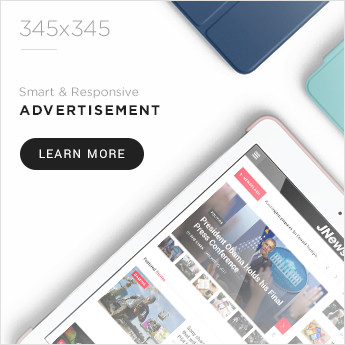وبالرجوع إلى تاريخنا المجيد وما أفرزته المدرسة المحمدية والبيت المسلم من نماذج رائدة من العطاءات المتميزة في الحضارة الإنسانية عبر العصور، استفاد منه الغرب أيما استفادة في تشييد صرح العلوم الحديثة وإقامة دعائمها والأخذِ بأسباب النهوض بها في مجال الاختراع والاكتشاف والبحث العلمي عن طريق العقل والترجمة والاقتباس، فإننا نجزم بأن العقل العربي والفكر الإسلامي كان حضوره قويا وفعالا في الساحة العلمية، ولم يكن الدين الإسلامي حائلا ولا عائقا دون إعمال العقل وتنمية الفكر وتفتيح الملكات المعرفية، ورفض التقليد والانكباب على اجترارِ مخالفات الماضي، بل كان دائما فكرا متجددا متطورا، يتجدد ضمنيا بتجدد الظروف الزمانية والمكانية.
فالمدرسة النبوية التي تربي فيها علماؤنا وفقهاءنا ومخترعونا ومفكرونا ومكتشفونا كانت الأرض الخصبة المعطاء التي سطعت منها شموس العلوم والمعارف وعمت بنورها أرجاء الكون في وقت كان العالم فيه يعيش في جاهلية وتخلف وضلالة، وأعطت رجالا أفذاذا غذوا العلوم الإسلامية والمعارف العقلية والطبية والتربوية والفلسفية، وخدموها أجل خدمة مخلفين تراثا وعلوما لم تمحها يد الزمان، وكانت مشاركتهم الفعالة في جميع الميادين، واهتمامهم الشديد بعلوم من سبقوهم دافعا لهم على البحث والمعرفة حيثما وجدت ولو في أبعد الأقطار والأمصار.
لذلك ومن أجل استرجاع مكانة الأسرة المسلمة كما كانت في الماضي ودورها الأساسي في العملية التربوية والتنشئة الاجتماعية السوية، وتأثيرها القوي في تكوين وصياغة ملامح الشخصية المسلمة المتوازنة، المرتبطة بخالقها ارتباطا دائما، المتفاعلة مع مجتمعها الذي تنتمي إليه كان لابد من وضع الأسس الكفيلة ببناء قواعد هذه الأسرة بناء لا تخلخله الأحداث ولا تعصف به رياح الأهواء الفاسدة والشعارات الخادعة فالأسرة هي البيئة الاجتماعية الأولى التي ينتمي إليها الإنسان، وعالمه الجديد الذي يتلقفه مباشرة إثر تفتح عينيه على نور الدنيا، والمدرسة الطبيعية التي يتدرب فيها على خطواته الأولى في درب الحياة المليء بالورود والأشواك. وانطلاقا من كل هذا يتبين لنا أن مسؤولية الأسرة مسؤولية جسيمة، والقيام بواجباتها والتزاماتها أمام الله وأمام الأبناء يتوقف عليه مستقبل المجتمع وآمال الأمة وحتى ينطبق عليها قوله عز وجل: }كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ { آل عمران 10.
ولما كان طفل اليوم هو رجل الغد وعدة المستقبل فإن حث الإسلام على تكوين الأسرة الصالحة حفاظا على الطفل، وتهيئة للظروف والأسباب الكفيلة برعايته جسما وعقليا واجتماعيا وخلقيا ونفسيا ودينيا، باعتباره محور العملية التربوية وقطب الرحى في كل تخطيط كان تربويا أو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو تعليميا، ذلك أن تأهيل الطفل يعني تأهيل الإنسان، وبالتالي تأهيل المجتمع ككل، وهذا التأهيل لن يعطي ثماره المرجوة ويحقق نتائجه المنتظرة إلا إذا لبينا احتياجاته اللازمة والأساسية، وحرصنا كل الحرص على منحه كافة الحقوق التي وهبتها له الشريعة الإسلامية والفطرة الربانية. والجدير بالذكر أن الإسلام كان سباقا إلى تحديد وضمان حقوق الطفل في جميع مراحل حياته بدءا من المرحلة الجنينية بل قبل لحظة الميلاد، فحث على اختيار الأم الصالحة المسلحة بالإيمان والأخلاق الفاضلة القادرة على تسيير شؤون الأسرة وصيانتها وضمان حقوقها عن طريق التربية والتنشأة الراشدة لأولادها، الهادفة إلى الغاية السامية والمقصد الشرعي من إقامة مؤسسة الزواج الذي جعل الله له قداسة وحرمة عظيمة ومكانة عالية، فقد وصفه الله بالميثاق الغليظ بين الزوجين }وأخذن منكم ميثاقا غليظا{ النساء 21. ذلك أن مؤسسة الأسرة هي الصورة المصغرة للمجتمع لها تكاليفها وقضاياها ومشاكلها والتزاماتها فلابد من التعاون والانسجام والتفاهم والتشاور بين الزوجين، لأن ذلك من شأنه التخفيف عنهما من تكاليف الحياة المتعددة، ويسهل عليهما القيام بواجبهما التربوي والأخلاقي والديني والمجتمعي.
وبهذا ينشأ الطفل ويترعرع في بيت أقيم على تقوى من الله ورضوانه، تحفه عناية الوالدين وتحيط به أجواء الطمأنينة والأمان والمحبة والرحمة والحماية، فتكسبه مناعة ضد الانحرافات والمفاسد وأسباب التحلل العقدي والخلقي والاجتماعي والتفسخ الذي يمكن أن تجرفه إلى مالا تحمد عقباه. فالأسرة بما يشيع بين أفراده من ممارسات دينية وأخلاقية عملية، لاشك أن الطفل سوف يمتص تلك المبادئ والقيم، ويقتدي بسلوكيات أفراد الأسرة عن طريق التقليد والمحاكاة والمعاشرة اليومية فتصبح جزء لا يتجزء من سمات شخصيته، فأفراد الأسرة الحريصين على أداء الشعائر الدينية والقيام بالتكاليف الشرعية المطلوبة على الوجه الأكمل، والمحافظين والملتزمين بقول الصدق وأداء الأمانة والمعاملة بالحسنى إلى غير ذلك من القيم الإسلامية الأخلاقية التي حث عليها ديننا الحنيف إنما يرسمون بذلك ويخططون لبناء الأسر والبيوت المسلمة الصالحة، وبالتالي قيام المجتمع الإسلامي الراشد، والمحافظة على الهوية الإسلامية في خضم تعدد الخصوصيات الكونية في عالمنا المعاصر.
ومهما يكون من أمر فإن موضوع حقوق الطفل يحظى باهتمام كبير وعناية بالغة، انطلاقا من كون رعاية الطفولة تمثل ضرورة اجتماعية ملحة، غايتها حفظ النوع البشري واستمرار الحياة على وجه الأرض، ونقل التراث الإنساني من جيل لآخر، وإعداد الإنسان القادر على المساهمة الإيجابية الفعالة في تنمية المجتمع والنهوض به. فرعاية الطفولة تبتدأ من الأسرة الصغيرة وتنتهي في الأسرة الكبيرة أي المجتمع عامة الذي تنعكس عليه آثار التربية الأسرية الأولى بسلبياتها وإيجابيتها، وهو الأمر الذي تركز كل الأديان السماوية على مدى أهميته وخطورته وأبعاده الحضارية والإنسانية، لذلك حرص الإسلام كل الحرص على تفضيل وتكريم الإنسان على سائر مخلوقاته وأوجب احترام حقوقه وتقديره التقدير اللازم، وعدم الاعتداء عليه، وحفظه في نفسه وماله وعرضه وإنسانيته، واعتبر الإسلام رعاية الطفل مسؤولية الأبوين المسؤولية الكاملة بجانب ما تتقاسمه الأسرة مع مؤسسات أخرى تربوية كالمسجد والمدرسة والوسط الاجتماعي والحي والأنشطة التعليمية والرفقة وغير ذلك من الفضاءات العامة المرتبطة ارتباطا وثيقا بمجال الطفولة والشباب، فالمنظومة التربوية بمعناها الشمولي تتداخل فيها بالأساس أطراف عدة، دون الاعتماد على جانب دون آخر وإنما تمتد لتشمل التربية العقلية والاجتماعية والجسمية والنفسية، فمنهج التربية الإسلامية يمتاز بالشمول ويهتم بالتربية التكاملية للإنسان تحقيقا للكرامة الإنسانية، ووصولا إلى هدف التربية الأسمى، وهو إسعاد الفرد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: }وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ{ القصص77.
يُتبع
د.ة زبيدة بن علي الورياغلي