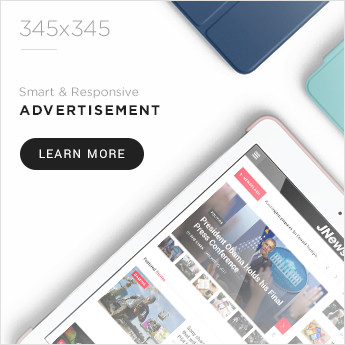توالت الاحتفالات بمناسبة الأعياد لكن، لم يسمع أحد بنبأ عن عيد للتعليم و التدريس، قد يكون مناسبة لمناقشة قضايا الوضع التعليمي بالمغرب، لاسيما بعد توالي الانتكاسات التي أصيب بها التعليم العمومي و انحدار رتبته إلى الدرك الأسفل بين أمم العالم، ما دفع المتابعين للشأن التربوي بالبلد إلى وصف التعليم باللون القاتم.
لقد اعتبر تقرير رسمي أن الواقع التربوي يرزح تحت نير مفارقات عملاقة، مفارقات تجعل المدرسة العمومية مجالا رحبا لإنفاق الأموال العامة و إنهاك خزينة الدولة، لكن دون طائلٍ يُذكر مقابل هذا الإنفاق، بمعنى أن الانفاق، لا يعدو كونه “عملية إفْراغ لِدِلاءِ الماء في صحراءَ قاحلةٍ”.
أبرز المفارقات التي رصدتها التقارير هي عدم الوضوح في برامج التربية و عدم الانسجام الذي يطبع منظومة القيم المدرسية”، وهي تكشف، في الواقع، مدى العشوائية التي تسود تدبير الشأن التعليمي و التربوي الوطني، و تقتضي، بحكم المنطق ، مراجعة شـاملة تتسم بالعُمق في تحديد المرامي و الغايات و التعقل الاستراتيجي في رسم الأهداف و توظيف الوسائل الملائمة لبلوغها.
لعل كثيرا ممن عاصروا مقرراتٍ دراسيةً تضم برامجها مؤلفات أحمد بوكماخ، يعتريهم الحنينٌ العارم بالعودة إلى فصولهم الدراسية القديمة و الاستماع بانتباه مُكتسب لدروس يُلقيها معلِّمون أوتوا احتراماً غزيراً و سطوة لا تُضاهى .
لا يتساءل أكثر الناس عن السر في تجدد الحنين في كل مُناسبة إلى الحديثٍ عن قضايا التربية و التعليم. هل هو مجرد فعل “أخرق” يرتبط بسلوك نفسي معروف عن الإنسان العاشق للماضي ؟ أم أنه تعبير سلبي عن رفض ما آل إليه التعليم و انتهت إليه برامجه العشوائية؟
تعبير، يستند في أحكامه على عقد مقارنات محددة بين ماضي التعليم و حاضره ؟ مقارنات تهم موضوع البرامج الدراسية و أساليب التدريس، كفاءة المدرسين و انضباط المتمدرسين، و لا تُغْفِلُ أخلاقيات و قيم التربية.
لقد توارت عن الأنظار تلك الصورة المِثال التي بنتها الأجيال السابقة عن المدرسة و حُرمتها الأدبية، و رسمتها عيونُ الحالمين عن المعلم و عن مكانته الراقية.
في الماضي، الجميل كما نراه دائماً، كان التلاميذ، بكل انتماءاتهم الطبقية و العرقية و الدينية، يجتمعون في انضباط عسكري أمام “ضابطٍ سامٍ” برتبة معلم، وبالطبع، لا يملك هؤلاء غير الالتزام بقواعد التعلم الأساسية، قواعد لا وجود في قاموسها لمفردات نظير المحاباة و المجاملة أو التمييز بدافع ما يُعرف دروساً خُصوصيّةً.
الآن، يبدو أن الأمور تغيرت بشكل مثير للسخرية اللاذعة، تغيرات همّت كل شيء إذ صار هندام التلميذ، أقرب لصورة البهلوان منه لمظهر تلميذ، فالواحد يعتريه الاندهاش حين يشاهد واحدا من هؤلاء يرتدي سروالا يكشف أجزاء عريضة من مؤخرته و أطرافا من فخذيه و ساقيه، بل قد ترى أمامك واحدا ممن نظم فيهم شاعر ساخر:
لا بـأس إن دخـل الـمـدارس طـالـب بـسـيـجـارة أو جــاءهــا مـسـطــولا
أما المعلم، الذي شبه بالرسول، فقد أضحى لا يعلم شيئا عن العلم و ضروبه، و لا يدري شيئا عن التعليم و فَنِّيات تلقينه، فهو مسطولٌ على الدوام و دائم الغياب، حتى إن أحد الساخرين نـظم في حال المــعلم قـائلا :
إنْ غـابَ شَـهْـراً فالغِـيـابُ فَضيـلَـة و غَـدَا السُّـؤالُ عَـن الغِيـابِ فُضـولاً
لقد فسد التعليم بهذا البلد، وهو فسادٌ يُنذر بأشد المخاطر، بالنظر إلى طبيعة المجال الذي لحقه، لكن مخاطر هذا الفساد تتضاعف آثاره المدمرة بالنسبة للبناء المجتمعي بمكوناته و أركانه، الاقتصادية أو الثقافية و ربما السياسية ، وهذا هو الأخطر.
إن قلة من الناس من هم على بينة و دراية بحجم و كلفة الاستثمار العمومي في مجال التعليم، إنه استثمار يسعى الجميع إلى مضاعفته بغية ضمان تعميم التدريس على الجميع، لكن الرفع من حجم الاستثمار لا يعني بالضرورة بلوغ الغاية المرجوة، فالاستثمار المالي مجرد وسيلة، و الوسيلة وحدها لا تجدي نفعا إلا إذا واكبتها سياسة رشيدة و راشدة، سياسة تستهدف الرفع من كفاءة النظام التعليمي، على الأقل إلى الحدود التي تجعله يبرر تلك الاعتمادات الضخمة التي تصرفها عليه الخزينة العمومية، و إلا فما الداعي لهذا الإنفاق إذا لم يحقق الغايات المطلوبة ؟ و هل يجوز صرف الأموال العامة بالباطل الزهوق لمجرد تبرير أن الدولة تنفق على مرفق التعليم، أليس هذا مجرد لغْو مُكلِف لا يحل مأزق التربية؟