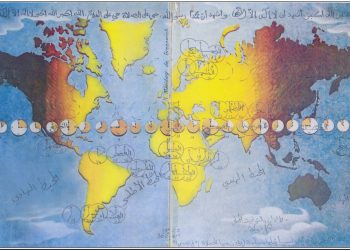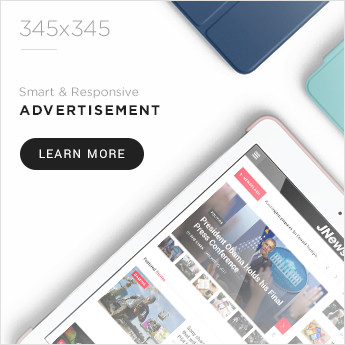تربية الأبناء في ظل الإنفتاح .. ترى ما نسبةُ التفاؤل المتوقعة لنجاح جهود الآباء في تربية الأبناء في ظل هبوب رياح الشرق والغرب ومحاولاتها المستمرة في اقتلاع الثوابت، وتبديل القيم، وإحلال ثقافة مستوردة لا صلة لنا بها، ولا شيء مشترك يجمع بيننا؟!
جريدة طنجة – لمياء السلاوي (تريية المثلى للاطفال )
الثلاثاء 03 يناير 2016 – 12:03:06
وتربية الأبناء وتعهدهم هي الخطوة الرئيسة والتحدي الهام الذي يتوقف عليه مستقبل الأمة ، وخاصة في زمن كثرت فيه المغريات، وظهرت فيه التيارات، وانتشرت فيه الرذيلة، والفساد، وانحرف بعضهم عن جادة الطريق بالآثام والمعاصي وغيرها، يساعد في ذلك قوى الظلم والطغيان بما يملكون من قوة مدمرة، وتحولات تقنية متسارعة ومذهلة، ونفوذ على الأرض، كل ذلك لغزونا فكرياً وثقافياً ونفسياً وعلمياً وصحياً، وفرض تحديات واقعية على شبابنا، لجعلهم في اضطراب دائم، ليس لهم نهج أو خطة أو هدف، أوضاعهم الصحية والمعنوية والنفسية في تدهور مستمر، لا يتمكنون من عمارة الأرض والقيام بدورهم كبشر، “فلا يقيمون وزناً للدار الآخرة والإيمان بالله في أمور الحياة الدنيا التربوية والٌإقتصادية، والسياسية والإجتماعية، وفق خُطَّة مدروسة ونهج محدّد وأهداف واضحة لديها” .
وقد أدرك ذلك الرسول الكريم – عليه الصلاة والسلام – وتلاميذ مدرسة النبوة منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، فكانوا عيوناً ساهرة تراقب الأبناء قبل أن تعصف بهم ريح الشيطان إلى مهاوي الردى، ومزالق الإنحراف وطرق الضلال، فعملوا على بنائهم، انطلاقاً من المسجد منارة العلم والنور والتربية والتوجيه والبناء والتعهد، إدراكاً منهم أن الأمة لا يمكن أن تنهض إلاّ برجالٍ أخلصوا النية لله، واجتهدوا في بناء فلذات أكبادهم وتربيتهم التربية الإيمانية الصالحة لكل الأزمان والعصور، فكانت النتيجة أنهم استطاعوا تغيير المجتمع الجاهلي والمتخلف الظالم إلى مجتمع متقدم متعلم يسـوده العدل والرحمة والإحسان، والمحبة والمساواة، متخلصاً من العصبيات الجاهلية التي كانت تعصف بالمجتمع. ومن الأهمية بما كان، إدراك أن مهمة التوجيه والإرشاد وتربية الأبناء مهمة شاقة، ومن أعظم المهام التي يقوم بها الإنسان في حياته الدنيا، للخروج من الذل والهوان والإحباط الذي تعيشه الأمة المسلمة إلى القوة والعزة والمنعة، لنيل رضا الله والأجر العظيم، ولكي يتمكن الوالدان من رسم معالم الطريق لأبنائهم، بتربية صالحة، وسعادة في الدارين.
ترى ما نسبةُ التفاؤل المتوقعة لنجاح جهود الآباء في تربية الأبناء في ظل هبوب رياح الشرق والغرب ومحاولاتها المستمرة في اقتلاع الثوابت، وتبديل القيم، وإحلال ثقافة مستوردة لا صلة لنا بها، ولا شيء مشترك يجمع بيننا؟!
وكيف يتصرف الآباء والأمهات وهم الحريصون على إكساب أبنائهم مناعةً أخلاقية تحميهم من آفات الإنفتاح العشوائي على ثقافات العالم إذا ما وجدوا قوة في الريح التي تجذب أبناءهم في المقابل على هويتهم من التشويه أو الإنقلاع؟

ومع اجتهاد الآباء والأمهات في التعريف بالطريقة المثلى التي تضمن السير في الاتجاه الصحيح، إلا أن الخوف من حدوث ثغرات في الفهم ونقص في الاستيعاب يبقى قائمًا، فهل تتوفر للأبناء قدرة كافية للحفاظ على توازنهم وسط لوثة الأفكار وهشاشة البنية الثقافية المستوردة المراد ترسيخها في المحيط الاجتماعي؟!
إنها مشكلة تبدو صعبة الحل، ولغز يبدو عسيرًا على الإجابة، ومعضلة تحتاج إلى متخصص ليفك طلاسمها ورموزها، فكيف يعيد الأبناء ترتيب أوراقهم من جديد؟! وكيف يتمثلون الصورة المثالية الرائعة التي رسمها لهم الوالدان عن الشخصية الناجحة التي تثير إعجاب الناس، وتستحوذ على اهتمامهم، ما دامت ملتزمة بالمبادئ والقيم، وهم يرون المثل الجميل يتحطم أمامهم كل يوم ،
هل تعدُّ التربيةُ القائمة على القمع والإرهاب والتخويف وقتل المشاعر والإحساسات وصياغة الشخصية الجافة الصارمة الناقمة على المجتمع – الأسلوبَ الأمثل لتربية هذا الجيل؟
هل عبارات وتوجيهات (اسكت يا ولد.. لا تجلس مع الكبار.. أنت لا يعتمد عليك.. أنت فاشل.. فلان أحسن منك.. عيب عليك أما تستحي.. سودت وجوهنا.. ما فيك خير.. والحرمان من المال أو السيارة.. أومن الخروج مع الزملاء بحجة عدم الوقوع في المحظورات.. واختيار نوعية الأكل والشرب واللباس.. وقسر الأبناء على دراسات لا يرغبونها.. وإجبارهم على اعتناق أفكار لا يؤمنون بها..)
هل هي أساليب مجدية..؟
هل استخدام العصا والنهر والزجر والصراخ في وجوه الأبناء.. وركلهم ورفسهم وجرهم من شعورهم.. والبصق في وجوههم.. وتحقيرهم.. والتعامل معهم بفوقية وفرض الطاعة المطلقة عليهم – أساليبُ وطرائقُ تتوافق مع طبيعة عصرنا الحاضر؟

وبعد..
فإن التربية تعد أمرًا معقدًا لا يستطيع القيام به كل أحد، وكلما اتسع نطاق البيئة التي تتم فيها هذه المهمة ازدادت صعوبتها وبرز فيها خطر التأثر بما يمكن تلقيه من أفكار وسلوكيات، وفي عصر العولمة صارت البيئة هي العالم كله، على ما فيه من اختلاف في الديانات والثقافات، يزداد حينًا ليكون تضادًّا ويقل حينًا ليكون تنوعًا.
إن زماننا هذا زمن الإنفتاح والمتغيرات، ومع كثرة التقنيات والفضائيات وكثرة الثقافات والشبهات أصبح الشباب يعيشون اليوم في مفترق طرق وتحت تأثير هذه المتغيرات ولا شك أنها تسبب لهم كثيرًا من المشكلات التربوية والأخلاقية.
لقد أحدثت الفضائيات والشبكة العنكبوتية (الإنترنت) تغيرًا مهمًا في المجتمعات بما قدمته من وسائل للاتصالات، جعلت العالم ينساب بعضه على بعض، فلا حدود ولا قيود تقف في وجه انتقال المعلومات، والتربية بحكم عملها وطبيعتها أكثر جوانب المجتمع عرضة للتغير؛ وبناء على ذلك فالمتغيرات الحادة التي ينطوي عليها عصرُ المعلومات وعصر الانفتاح، ستحدث تغيرًا كبيرًا في منظومة التربية؛ مناهجها وأساليبها وأثرها, ولذا أصبح من المهم مراجعة منظومة التربية لتتوافق مع الأثر الذي ستؤديه في زمن الإنفتاح.
لم يعد المربي هو من يوجّه فقط, ولم يعد المتربي رجلا سِلْمًا لمربّيه، بل فيه شركاء آخرون, فالقنوات الفضائية وما تبثه من إغواء أو إغراء تخالف قيم المجتمع الإسلامي وتدعو إلى الفحش والرذيلة, والشبكة العنكبوتية وما تحمله في طياتها من مواقع إباحية أو عدائية ومقالات تدعو إلى مساوئ الأخلاق, وفي المقابل طرح خيارات فكريه تشوه الأفكار الإسلامية الصافية وتحارب مبادئه وقيمه الزكية, وتنوع مجالات الانفتاح وازديادها بحيث لا يمكن حجبها، يزيد من صعوبة التربية في زمن الانفتاح, لقد أصبحنا عبر السماء نستقبل أفكار الأمم وثقافتهم وما يبث من سموم.
لم يعد من السهل على أبنائنا وشبابنا الوقوف أمام هذه المغريات دون أن يكون هناك من يمد لهم يد العون والمساعدة من المربّين, ولم يعد من السهل على المربين أن ينجحوا في مهمتهم في تربية الأجيال ما لم يفقهوا التربية في زمن الإنفتاح.
لقد أصبح أمامنا كمربين العديد من التحديات التي تجعل من موضوع التربية الأسرية وغير الأسرية إشكالية يلزم تمحيصها والتفكر فيها حتى يتسنى لنا اتخاذُ القرار السليم. وتتمثل أهم التحديات في الانفجار المعرفي المذهل الذي يحتاج مواكبةً سريعةً من قبل الأجيال القادمة، والمتناقضات السياسية الخطيرة التي يعيشها مجتمعنا العربي والإسلامي وما وصل إليه هذا المجتمع من ضعف شديد وما يحمله هذا الوهن من مضمون سيئ يستشعره الشاب فيزلزل كيانه ويوهن عزيمته وثقته.
إننا في عصر الانفتاح غير المعهود على ثقافات غريبة يسَّرتها لنا وسائلُ الإعلام الحديثة ،فبالأمس كان هذا الانفتاح محدودًا وكان اطلاع الأبناء على هذه الثقافات تحت إشراف الوالدين نسبيًّا. أما الآن فإننا نعيش مشكلة كبيرة تتمثل في هذا الفيض الجارف من المفاهيم والقيم الأجنبية الوافدة إلينا والتي بدأت آثارها المدمرة تبدو جلية فيما نشهده من مشاكل لم تعهدها مجتمعاتنا سابقًا (العلاقات الجنسية عبر النت، العلاقات غير الشرعية مع المحارم، الممارسة المثلية…..الخ).
لقد أصبحت عقول وأفكار وأخلاق أبنائنا ميدان سباق, والدعاة والمربون أحق من ينافس وأجدر من يسابق للوصول إليها وحمايتها من كل زيغ أو فساد. ففي ظل هذا الإنفتاح تتضاعف مسؤولية المربين في تربية النشء وفي إعداد جيل يحمل مبادئ الإسلام وقيمه, وفي ظل هذا الانفتاح يزداد العبء على الدعاة والمربين للوصول بالجيل الناشئ إلى بر الأمان بعد توفيق الله تبارك وتعالى.
فهل أدوات البناء عند المربين تنافس الإغراءات المطروحة؟ وهل تنافس حجم التجديد والابتكار في الجذب والإغواء؟ وهل المراجعات لمنظومة التربية الدعوية كافية لتناسب زمن الانفتاح؟ وما السبلُ الكفيلة بتربيةٍ صحيحة في هذا الزمنِ زمنِ الانفتاح والعولمة؟
لقد تحول الجزء المؤثر والكبير في التربية الآن من المؤثرات الأساسية، وهي الأسرة والمسجد والمدرسة، إلى مؤثرات جديدة معاصرة، تتجاوز حدود البيئة المحلية، إلى بيئة لا هوية محددة لها، ولا ضوابط واضحة تحكمها، وصار لها الكلمة الأولى في تحديد أخلاق الأجيال وثقافتها، هذه المؤثرات هي التلفاز, وأطباق الاستقبال، والكمبيوتر, والإنترنت، ، وألعاب الفيديووغيرها..!
لم يكن أحد يشعر بآثار هذه الوسائل السلبية؛ لأنها قد يكون لها آثار إيجابية متوقعة, وحاجة الحياة المعاصرة إلى هذه الوسائل كبيرة وملحة، كما أن آثارها السلبية لم تظهر مرة واحدة – مع تحذيرات كثير من التربويين منها قبل انتشارها -، وإنما ظهرت أولا محدودة نوعًا ما، ثم أخذ أثرها السلبي في الظهور والاتساع بمرور الزمن, وتطور تلك الوسائل وانتشارها.
والخطير في هذه القضية هو حجم التأثير الكبير والعميق وسرعة التغيير الذي تحدثه تلك الوسائل المعاصرة في مستوى التدين والثقافة والسلوك والمفهومات والذوق العام على شبابنا وفتياتنا، فمحاولات التغريب كانت تسير في مجتمعاتنا ببطء شديد، ولم يكن دعاة التغريب يحلمون بحدوث التغيير إلا بعد أجيال عدة، أما بعد انتشار تلك الوسائل الإعلامية والثقافية فمكاسب التغريب صارت أكبر كثيرًا مما كان يحلم به أولئك، فالتغيير في الأخلاق والمفهومات أصبح الآن يحدث عبر جيل واحد مرة أو مرتين.
وهذا التغيير السريع والتأثير الفوضوي الكبير يؤدي إلى إخفاق العمل التربوي في المجتمع، ويسبب له الإرباك والتهدم، وتتفسخ الروابط بين الأجيال، ويرى كل جيل لنفسه الحق في التبرؤ من الجيل الذي سبقه، والاستقلال عن مفهوماته وأجوائه، حتى يفقد الوالدان القدرة على التفاهم مع أولادهما، ويقعان في حيرة في اختيار نوع التوجيه المناسب لهم، ويعجزان عن السيطرة على تصرفاتهم وتقويمها، بل ربما لا يجدان الوقت لممارسة التوجيه والتربية سواء في المواقف أو الأقوال، ليس لانشغالهما؛ بل لأن أولادهما لا وقت لديهم، لانشغالهم بالكمبيوتر أو الإنترنت!
هل نغلق هذه السماوات المفتوحة أمام أبنائنا ونسجنهم داخل عباءتنا أم أن هذا مستحيل والأجدى بنا أن نمعن التفكير في بديل لما نتبعه من تربية حالية. بديل ثوري يغير كثيرًا مما ألفناه؟
بديل يتطلب منا أن نغير ما ورثناه من علاقات مع آبائنا فنتنازل عن هذه الفوقية التي نعامل بها أبناءنا ونهبط معهم إلى معترك الحياة لنقف معهم جنبا إلى جنب أمام اللغز الكبير الذي تطرحه تحديات ومعطيات العصر الحالي. التربية التي ننادي بها هي تربية ناقدة تسمح لأبنائنا بالتفكير وطرح الأسئلة حول كل ما يدور حولهم من أحداث. تربية حرة لا تقيد التفكير بدعوى شعارات زائفة أو قيم موروثة ما أنزل الله بها من سلطان. لم يعد يكفينا أن نمد أبناءنا برصيد قيمي أو ديني ثم نتركهم وحيدين في هذه الحياة.
نحن جميعاً مسؤولون أمام الله بواجب الرعاية، والتعهد، والبناء، التي أمرنا الله بها، فهل تمت مراقبة الأبناء وتوجيههم بالإشراف الدقيق عليهم، وبذل كل الوسائل الإيمانية والتربوية لتنشئتهم على الإيمان والخُلق والفضيلة؟! ، وهل كنا قدوة حسنة لهم؟! هل رأوا فينا نحن الآباء والأمهات أمثلة صادقة يحتذى بها؟! هل رأوا فينا الإستقامة والأمانة، والصدق والعفاف، والنهج والتخطيط، والتزام كتاب الله وسنة نبيه الكريم؟! هل حاولنا تنمية قدراتهم ومواهبهم بالتدريب على أهم قواعد الممارسة الإيمانية والتطبيق، من أجل المساهمة في بناء أمة قوية قادرة على استيعاب تلك التغيرات المتسارعة، والتحولات الحادثة في عصرنا، لحماية الروابط الإيمانية بين أبناء الأمة، فإن كنا كذلك فالحمد لله، وإلا فيجب محاسبة النفس، وتعديل المسار، وتصحيح الطريق، والشعور بعظم المسؤولية، من خلال التربية والتعليم والبناء والتعهد، وتفعيل ذلك في نفوس الأبناء والبنات..