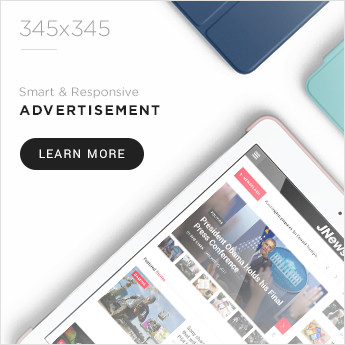استطلاع: المتقاعدون بالمغرب.. مواجهة الحياة بمعاشات هزيلة و روتين قاتل
جريدة طنجة – ل.السلاوي ( وضعية المُتقاعدون بالمغرب )
الثلاثاء 15 شتنبر 2015 – 11:48:28
وأطلب من القارىء العزيز، أن يقوم بعملية مقارنة بسيطة جداً في أوضاع المتقاعدين في بلادنا مع أقرانهم في الدول الأخرى، فالمتقاعدون في بلادنا نقرأ في وجوههم مظاهر الإنهاك، فمنهم من يكابد الأمراض، ومنهم من يعيش في كآبة وضيق ونكد، ومنهم من تتقطع أحشاؤه جوعاً وتتشقق شفاهه عطشاً، ومنهم من يعيش مأساة ولا يعلم بهم أحد، فتراهم يجرون أرجلهم بخطى ثقيلة تساعدهم بذلك العصي، من أجل الوصول إلى مكاتب البريد لاستلام الراتب الهزيل. والمؤسف والمحزن أنه حتى الراتب الزهيد الضئيل الذي لا يكاد يكفيهم هو مخصص لأسرة بأكملها.
ولعل الاختلاف في تقييم وتصنيف التقاعد، عائد بالدرجة الأساس إلى غموض مفهومه والتباس دلالته ومعناه، بل حتى غياب ”ثقافة التقاعد” التي يمكن أن تشكل قاسماً مشتركاً لمختلف الرؤى والآراء والقناعات على الصعيد الجماعي أو العالمي فمن الشعوب من تقرأ التقاعد بنظرة إيجابية، وتصنفه كتكريم للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة الوظيفية، ومن الشعوب من تقرأه بصورة مغايرة، وتعتبره عقوقاً لمن أعطى وأخلص، وتنكراً لجهوده وخدماته تمهيداً لالقائه في الشارع.
في المغرب، هناك فزع من التقاعد ومقت له وتخوف منه، ربما لأنه يرتبط بالمقهى والسيجارة أو “السبسي” وفائض الوقت الذي لا يعرف المتقاعد المغربي كيف ينفقه، بعدما أصبح خارج دائرة الدوام والانضباط والروتين الوظيفي المعتاد، أما في الغرب فالأمر مختلف إلى حد بعيد، ربما لأنهم هناك لا يعاقرون المقاهي التي تفوح منها روائح الدخان المختلف المصدر وطاولة الشطرنج وأوراق الكارطة، بل يعمدون إلى تزجية أوقات الفراغ عبر مزاولة الأنشطة السياسية والأعمال الخيرية والمهمات التطوعية والهوايات الفنية والأدبية والرياضية… وفي هذا المعنى تقول سوزان ميلر: ”مفتاح التقاعد، هو العثور على السعادة في الأشياء الصغيرة”.
في المغرب، لم يكن يدري الكثير من المتقاعدين أن السنين تمر بسرعة، فالزمن قد تغير والكبر قد لاح بظلاله وظهر، والشباب قد ولى واحتضر والشيب قد غطى الرأس وغزر والشعر لم يعد له من أثر… حيث لم يعد على ألسنتهم غير ذكر الشاعر حين قال في الأثر: ”ليت الشباب يعود يوماً… فأخبره بما فعل المشيب”.
إنهم ببساطة رجال سلموا راية الكد والعمل، واستسلموا لمصير التقاعد. والسؤال المطروح: هل التقاعد نهاية القدرة على العطاء؟
يقال أن لكل بداية نهاية، شعار تعتبره شريحة واسعة من المتقاعدين في المغرب، عنواناً لحقيقة مفادها أن زمن الشباب بكل ما تحمله الكلمة من معاني القوة والعمل قد مضى وانتهى بلا رجعة حاملاً معه جميع الذكريات الجميلة منها والتعيسة، ولم يعد في قاموسهم سوى عبارة ”كي كنت أنا نخدم في صغري…” لأن العمر قد تقدم بهم إلى درجة عدم القدرة على العطاء، وليؤرخ لبداية مرحلة الفراغ والملل وتوقيف عقارب الساعة لأن كل الأيام القادمة ستكون متشابهة، ولا شيء سيشغل ساعات النهار الطويلة، وأنهم بهذا المصير أصبحوا أناساً لا فائدة ترجى منهم غير تلك المنحة التي يتقاضونها في مقابل السنوات التي قضوها خلال مرحلة العمل.
غير أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: لماذا تعتبر الساحات العمومية والمقاهي الملجأ أو الملاذ الوحيد لفئة كبيرة من المتقاعدين بالمغرب؟ وهل حقيقة أن دور الإنسان في الحياة ينتهي بمجرد وصوله إلى سن الستين؟ ولماذا تهمل هذه الخبرة الطويلة والطاقة البشرية الهائلة لهاته الشريحة الواسعة من مجتمعنا التي من الممكن استغلالها في مختلف مناحي الحياة؟

تساؤلات أردنا البحث عن إجابات لها من خلال استفسار بعض منهم عن واقع حياتهم بعد الإحالة على التقاعد، وفي هذا الشأن يقول ”إبراهيم” متقاعد منذ أكثر من عشر سنوات بعد أن وجدناه يتصفح إحدى الجرائد بساحة من الساحات العشوائية ، حيث جمعتنا معه دردشة قصيرة حول حياته ويومياته مع التقاعد: ”الحق أن عدداً كبيراً من المتقاعدين يستسلمون ببساطة إلى الروتين والملل الذي ينتابهم مباشرة بعد إحالتهم على التقاعد، حيث تصبح الأيام كلها متشابهة بالنسبة إليهم، وإن عدداً قليلاً فقط يفكر ويخطط لما بعد التقاعد وكيف يستثمر وقته عوضاً عن الشعور بالملل والضيق والفراغ… أما عن نفسي فهذا حالي منذ السنوات الأولى التي تلت إحالتي على التقاعد، ليس لي أنيس سوى هذا المكان الذي أجده متنفساً لي، أو متابعة بعض برامج التلفزيون، وكلما شعرت بالضيق أعرج نحو أحد منازل أبنائي المتزوجين لاستأنس بأحفادي الذين اعتبرهم خير أنيس وأمتع جليس للتخفيف من وحدتي”.
أما ”مبارك” الذي لم يبلغ سن الستين بعد و الذي أحيل على التقاعد مؤخراً بعد أن قضى أكثر من 32 سنة في إحدى الشركات العمومية المتخصصة في الأشغال العمومية يقول: ”أصدقكم القول أنني شعرت بتغير كبير بسلوكي بعد الأشهر الأولى من إحالتي على التقاعد حيث أصبحت أتعصب وأغضب لأبسط الأمور نتيجة الفراغ الرهيب، وصار ينتابني إحساس بالوحدة جراء ابتعادي عن أصدقاء العمل، والآن بعد مرور سنة ونصف تقريباً عن وضعي الجديد هذا أفكر ملياً في العودة مجدداً إلى ميدان العمل، حيث تقدمت بطلب عمل إلى إحدى الشركات الخاصة للعمل كسائق لأبتعد عن هذا الروتين لأنني لا زلت أحس بقدرتي على العطاء”.
ومن هذا المنطلق فإن فئة من المتقاعدين تعكف على إيجاد ما يشغل وقتها، فالبعض منهم يجد في الساحات والحدائق العمومية سبيلاً لقضاء وقت مع نفسه يحدثها وتحدثه ليسترجع ماضيه وذكرياته مع الشباب، وليخلو بها بعيداً عن متغيرات الزمن وصخب الحياة، في حين يرى العديد منهم أن ارتياد المساجد هو أفضل مكان لتمضية ما تبقى من العمر في التعبد والتوبة من أخطاء الماضي، فلا يبرحونها إلا بعد صلاتي العشاء والفجر، كما أنها فرصة لالتقاء جمع المتقاعدين الذين يلازمون المساجد لساعات طويلة للخوض في عدة نقاشات تخص أمورهم الدينية والدنيوية، في المقابل يعتبر آخرون منهم أن أحسن وسيلة أو طريقة للترويح عن النفس وقتل الوحدة وكسر الروتين بسبب هذا المتغير الجديد في حياتهم هو ارتياد المقاهي لارتشاف الشاي مع نظرائهم من المتقاعدين والتجمع حول الطاولات لممارسة اللعبة المفضلة لغالبيتهم ”الكارطة”.
عرجنا على إحدى المقاهي الشعبية بالمدينة القديمة، التي يقصدها كثير منهم لنكتشف سرهم، حيث وجدنا معظم الطاولات محجوزة ولا مجال للخوض معهم في الحديث لأنك بهذا ستفقدهم تركيزهم وتفسد عليهم حساباتهم بخاصة وأن التنافس كان في أوجه، حينها لم نجد غير صاحب المقهى لنستفسر منه عن المدة التي يقضيها هؤلاء حول طاولات ”الكارطة” فأجابنا بأن معظمهم يأتي بعد صلاة العصر ولا يبرحون المكان إلا بعد أن يرفع آذان المغرب، فالتوقيت عندهم مضبوط ولا يمكن لأحد أن يغيره، إلى درجة أنني أصبحت أعرف كل كبيرة وصغيرة عنهم. ليستطرد قائلاً كأنني أشعر بما يجول في خاطرهم من مشاعر الإحباط والاستسلام للواقع الجديد الذي حكم على حياتهم بالفراغ، لا تملؤها إلا طاولات ”الكارطة” – مضيفا – وفي اعتقادي أنه كان يتعين على المتقاعد أن يحاول ملء الفراغ من خلال إيجاد أنشطة مختلفة سواء داخل المنزل أو خارجه وممارسة أنشطة وهوايات تساعده على تغيير وضعه، والبحث عن اهتمامات جديدة تخرجه من الروتين والملل”.
لقد أصبحت شريحة كبيرة من المتقاعدين كالآلات الصدئة التي عفا عنها الزمن، لأنهم لم يجدوا من يمد لهم يد العون والمساعدة لانتشالهم من بؤرة الفقر.
هم عينة من المتقاعدين الذين ربما وجدوا في المقاهي والساحات سبيلاً ليشغلوا به أنفسهم، غير أنه كان من الأفضل إيجاد بدائل أخرى لهذه الفئة من خلال إنشاء نواد يمارس فيها المتقاعدون مختلف النشاطات والهوايات، حيث يكون النادي فضاء للاستفادة من خبرات هؤلاء المتقاعدين للمساهمة في صقل خبرات الجيل الجديد، حينها يمكن القول أنه من الممكن أن يكون التقاعد بداية وليس نهاية.
وإذا كنا لا نستطيع أن نؤمن لهذه الشريحة الهامة من المتقاعدين الراحة ولا نستطيع أيضاً عمل استراتيجية للتقاعد، فعلى الأقل علينا أن نحفظ لهم كرامة البقاء وتوفير مقومات العيش الكريم ونجنبهم الإذلال ونحفظ لهم شموخهم وكبريائهم.