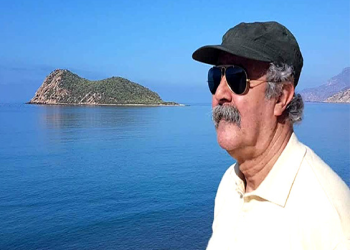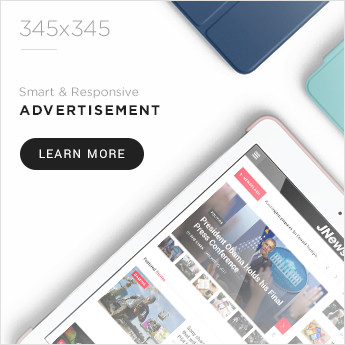حكاية عرس الجـان
جريدة طنجة – م.الحراق ( .حكاية الجان. )
الجمعة 08 غشت 2015 – 10:07:34
• من بين القصص التي كانت تحكيها الأمهات عن الجدات، أنه في بمدينة أصيلة، تلك المدينة الصغيرة الجميلة، حيث تتناسل فيها الأخبار بشكل سريع، كان رجل يطلق عليه اسم ” الجنيون”. الجنيون هذا حسب وصف رواته، كان قصير القامة، بشكل يشد انتباه الناظر، خفيف الظل، دائم النشاط والحركة والانشراح، بديهي النكتة، محبوب لدى سكان المدينة، ولخفة دمه، ودماتة أخلاقه، جعله يحظي بعطف تجار الثياب والملابس بقيسارية ساحة سيدي بنعيسى، بأن أمنوه على حراسة دكاكينهم، رغم أنه لاتوجد به ولو صفة واحدة من الصفاة التي يتصفون بها الحراس، تؤهله بأن يحرس دكاكين القيسارية، التي كان يوجد بها المسلمون واليهود المغاربة، ذلك أنه مابين دكان ودكان لأصيلي مسلم، كان يوجد دكان لأصيلي يهودي، وما بين منزل و منزل يَهودي، كان يوجد منزل لأصيلي مسلم.
ومن بين مظاهر هذا التعايش والتساكن بين المسلمين واليهود بهذه المدينة الصغيرة، كانت توجد زاوية أهل الشيخ الكامل زاوية سيدي بنعيسى في ساحة القيسارية، حيث تقام الصلوات الخمس، والأذكار وتلاوة القرآن والأمداح النبوية في المناسبات وغيرها، وبمسافة خمسة أمتارأو أقل عنها، كان يوجد كنيس لليهود يمارسون فيه طقوسهم وصلواتهم، وما بين الزاوية والكنيس اليهودي كانت هناك في الساحة دكاكين ومساكن، من بينها ثلاثة منازل تقطنها عائلات مسلم ويهوديان، الدورالثلاثة كانوا داخل ما يعرف لدى أهالي أصيلة بالديوان، يجمع العاءلات الثلاث، وله باب خارجي كبيرة، خلف الباب كان المعروف “بالجنيون” يتخده مقرا لحراسة دكاكين القيسارية، بل اتخده كغرفة نومه، عندما يخلو المكان من المارة، يغلق بابها الضخم وينام، وخاصة في أيام الشتاء، حيث البرد القارس، والليل أطول من ساعاته، والمصباح الكهربائي الوحيد المتبث على عمود الخشب الموجود بالساحة، من علته لا يشتغل ليلا الا إذا كان الجو صافيا، يظل مشتعلا طول النهار، وغير متقد في الليل.
كان “الجنيون” لا يبارح مكانه إلا بعد طلوع الشمس، لخوفه من “عيشة قنديشة” والعفاريت والجان، الذين يوجدون بمدينته، التي تزخر بالعديد من الأولياء الصالحين، وكل ولي صالح له قصة مع جني أو الجان كما ترسخت في ذهنه منذ أن كان طفلا.
في يوم من أيام فصل الشتاء، وكان قد صادف المولد النبوي الشريف، وكعادة سكان مدينة أصيلة وخاصة النساء منهم، يحيون هذه الليلة المباركة، في ضريح “للارحمة”، الواقع خارج الصور البرتغالي للمدينة.
في ذلك اليوم وبعد صلاة العشاء بقليل، خرجت مجموعة من نسوة المدينة، ومعهن بضعة بنات، في اتجاه ضريح للارحمة، ولم تثنيهن الأمطار والرياح التي اجتاحت المدينة في تلك الليلة المباركة من إحيائها، وأثناء مرورهن بالقيسارية والظلام بها دامس، تسللت من بينهن سيدة تدعى “افطيطم” وهي معروفة في المدينة بنكتها، وبتصرفاتها الخارجة دائما عن المألوف، حيث لا يخلو أي مجمع أو تجمع نسائي من حضور “افطيطم” هاته، لأنها تخلق في كل تجمع أو محفل جوا لا يخل من المرح والضحك، من خلال نكتها التلقائية، ومستملحاتها، في غياب الراديو والتلفزيون، كانت نجمة من نجوم الكوميديا، تروح عن نفوس النساء، وحتى الرجال أحيانا.
“افطيطم” اسم خرج من رحم فاطمة، والأغلب أنه للتمليح وليس للتحقير، ذلك أن سكان مدينة أصيلة من عادتهم تصغير أسماء الأشياء (فالموس مثلا يطلقون عليه المويس، والكأس الكويس، والخبز الخبيزة، والطاقة الطويقة، الزنقة الزنيقة، والعيلة العويلة … وغيرها) وقد اعتادو تصغير الأشياء في أحاديثهم ولربما متأثرين بصغر مدينتهم.
“افطيطم” هذه الأرملة العاقر، كانت قوية بدنيا، الشئ الذي جعلها مطلوبة كثيرا لدي نساء المدينة، لإعانتهم في غسيل الملابس، وما يسمى “الخمول” التنظيف و “التبييط” الصباغته، وكل الأشياء النسوية الشاقة، والخارجة عن قدرة واستطاعة ربة البيت لوحدها.
“افطيطم” تجردت من “الحايك” وهو اللباس التقليدي الذي كانت تتستر به المرأة الأصيلية في ذلك الزمان، في الأعياد والأفراح، والحفلات المنسباتبة، وفي غير المناسبات، لما تيقنت أن “الجنيون” يغط في نوم عميق، انقضت عليه كمن ينقض على السارق، ولقصير قامتة، وخفة وزنه، أخدته كطفل رضيع، ووضعتة على ظهرها، ولفته بمنديل يقال له “اللقام”.
“الجنيون” المسكين لم يدري ما أصابه والظلام قد أعمى عيناه، كاد أن يفقد صوابه، ولم يفه بكلمة، ولا دمدم، ولا همهم، ولاتمتم، ولا أبدى حركة، ولربما استطاب دفء ظهر”افطيطم” فاستلذ المكان، في يوم بارد قارس كذلك اليوم، أو تفكيره في الجان أخرسه عن الكلام، حتي هربت منه فاتحة الكتاب، وكاد أن يبلل سرواله من فرط الهول، راضيا بالقضاء والقدر، ظنا أنها عيشة قنديشة، أو جنية طائشة، حملته كالريشة، إلى عالم مجهول.
حطت “افطيطم” ضيفها “الجنيون” داخل ضريح الولية الصالحة للارحمة، وبالضبط وسط جمهور كله نسوة، يرتدين أجمل الملابس، ولما أماطت عنه ” اللقام” ظل الجنيون فاغرا فاهه، بفعل ما شاهده، نسوة بأزيائهن البيضاء، ورائحة الند والعود لقماري تفوح من “المبخريات”، كسحابة غطت سماء قاعة الزاوية، شموع متقدة، والذكر يصل مداه إلى عنان السماء، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تصدح بها الزاوية، مصحوبة بزغاريد النسوة الحاضرة.
كل هذا وصاحبنا “الجنيون” لم يدري ما حل به، يتساءل مع نفسه عن مصيره، في أي مكان يوجد، هل ما يراه حقيقة أم حلم أم خيال، والشيئ الذي أكد له أنه عين الحقيقة، كؤوس الشاي بالنعناع، وحلويات “كعاب واغريبية والفقاقس” التي كانت توزع على الحضور، ومن بينهم “الجنيون” الذي أعطوه منها نصيبه، ليتساءل مع نفسه ما هو السر في وجوده بين هؤلاء النسوة، ولماذا هو الرجل الوحيد بينهن في هذا المكان الذي لايعرف أين، هل هو في السماء أم في الأرض، يحضر عراسا من أعراس الجان، هل لأن اسمه يطابق اسم الجان، هذا ممكن في محاولة لإقناع نفسه، استنادا لما يراه ويعيشه، أسئلة طغت على تفكيره إلى أن أذن مؤذن الفجر، ليستخلص أنه بالفعل حضرعرسا الجنان.
و دون كَلل أو مَلل، أخَذت “افطيطم” صاحبنا الجنيون، ووضعته على ظهرها ولفته ب “اللقام” وغطته ب “الحايك”، وخرجت مع النسوة، وهن ينكثن طول الطريق، إلى أن وصلن إلى القيسارية، وحطت الجنيون في مكانه، وأحكمت غلق الباب عليه، وانصرفت مع النساء، بينما ظل الجنيون في مكانه متسمرا، يستعرض ما حل به، وكان بوده أن يطلق سيقانه للريح، إلا أن خوفه من “عيشة قنديشة” و”الغولة” أن يلقاياه في الطريق، ألزم مكانه رغما عن أنفه، إلى أن انبلج الصبح.
وقبل طلوع الشمس، كانت قصة “الجنيون” وما فعلت به “افطيطم” قد سرى بين سكان المدينة، سريان النار في الهشيم، بينما “الجنيون” كان يحكي بفخر واعتزازعن حضوره عرس الجان، وبأن جني حمله لحضور أحد أعراسهم، ويصف لأهالي أصيلة كيف استقبلوه وأكرموا وفادته، وأن عرس الجان لايختلف عن أعراس بني آدم، ويطنب تارة ويمدح أخرى، ويقسم بأغلظ أيمانه، بأنه حضربالفعل عرس جني مسلم، خالي من الشطيح والرديح و”الموسوخات” يقول، بل كله تلاوة للقرآن الكريم والأمداح النبوية، ويوريهم لمن يشكك في ذلك، الحلويات المتبقية من عرس الجان، وقد اختاروه هو لحضورعرسهم لأن اسمه “اجنيون” أي صغير الجان، وهو قطعا ينتسب إلى عائلتهم.